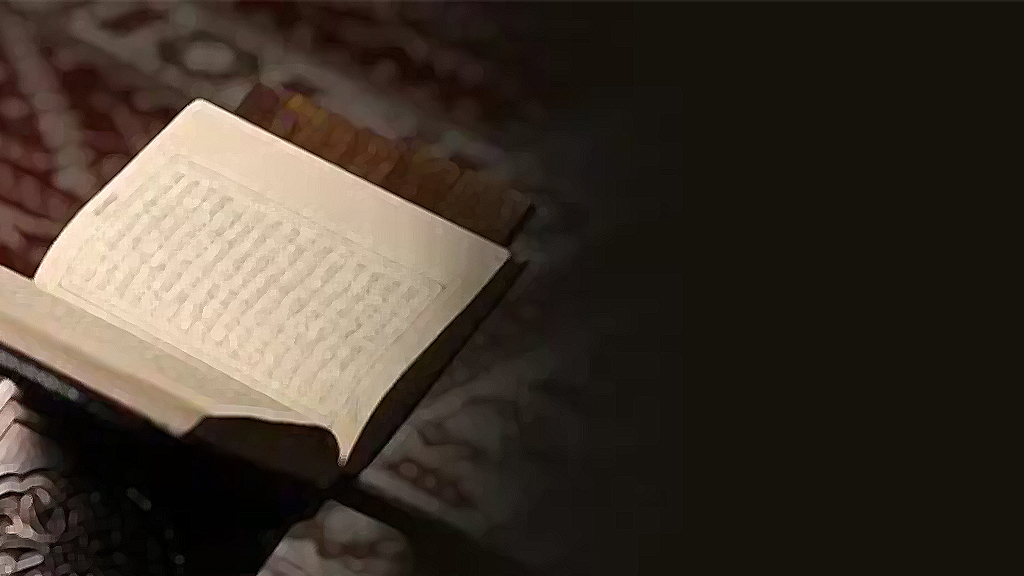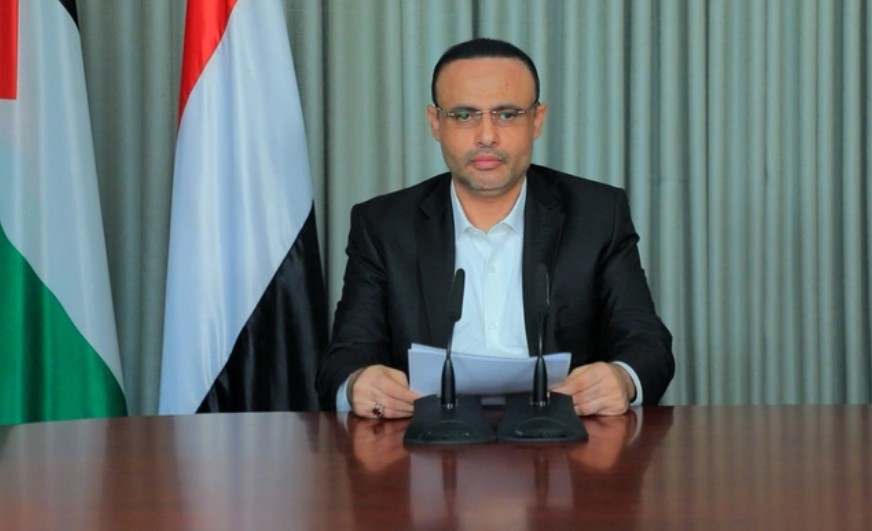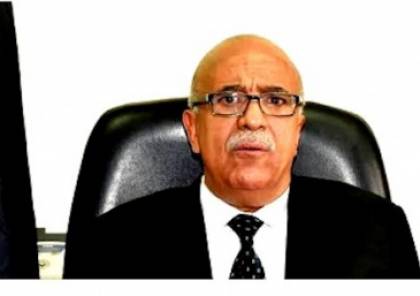تفسير سورة البقرة
الإمام / محمد عبده
“فتقلب الوجه فى السماء عبارة عن التوجه إلى الله تعالى انتظارًا لما كانت تشعر به روح النبى ﷺ وترجوه من نزول الوحى بتحويل القبلة.”
{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} (البقرة 144–147)
قالوا كان النبى ﷺ يتشوف لتحويل القبلة من بيت المقدس ويرجوه. بل قال (الجلال) إنه كان ينتظره؛ لأن الكعبة قبلة أبيه إبراهيم، والتوجه إليها أدعى إلى إيمان العرب.أى وعلى والعرب المعول فى ظهور هذا الدين العام؛ لأنهم كانوا أكمل استعدادًا له من جميع الأنام.. ولا يعد فى تشوفه إلى قبلة إبراهيم، وقد جاء بإحياء ملته، وتجديد دعوته، لا يعد هذا من الرغبة عن أمر الله تعالى إلى هوى نفسه. كلا، إن هوى الأنبياء لا يعدو أمر الله تعالى وموافقة رضوانه.
ولوكان لأحد منهم هوى ورغبة فى أمر مباح مثلاً، وأمره الله بخلافه، لانقلبت رغبته فيه إلى الرغبة عنه إلى ما أمر الله تعالى به ورضيه. بل المقام أدق، والسر أخفى. إن روح النبى منطوية على الدين فى جملته من قبل أن ينزل عليه الوحى بتفصيل مسائله، فهى تشعر بصفائها وإشراقها بحاجة الأمة التى بعث فيها شعورًا إجماليا كليا لا يكاد يتجلى فى جزئيات المسائل وآحاد الأحكام إلا عند شدة الحاجة إليها، والاستعداد لتشريعها، عند ذلك يتوجه قلب النبى إلى ربه طالبًا بلسان استعداده بيان ما يشعر به مجملاً، وإيضاح ما يلوح له مبهما، فينزل الروح الأمين على قلبه، ويخاطبه بلسان قومه عن ربه. وهكذا الوحى إمداد، فى موطن استعداد، لا كسب فيه للعباد. وإذا كان حكم شرع لسبب مؤقت، وزمن فى علم الله معين، فإن روح النبى تشعر بذلك فى الجملة. فإذا تم الميقات، وأزف وقت الرقى إلى ما هو آت، وجدت من الشعور بالحاجة إلى النسخ ما يوجهها إلى الشارع العليم، والديان الحكيم، كما كان يتقلب وجه نبينا فى السماء تشوقًا إلى تحويل القبلة. فذلك قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ}، أى أننا نرى تقلب وجهك إيها الرسول وتردده المرة بعد المرة فى السماء، مصدر الوحى وقبلة الدعاء، انتظارًا لما ترجوه من نزول الأمر بتحويل القبلة.
فسّر بعضهم تقلب الوجه بالدعاء. وحقيقة الدعاء هى شعور القلب بالحاجة إلى عناية الله تعالى فيما يطلب، وصدق التوجه إليه فيما يرغب. ولا يتوقف على تحريك اللسان بالألفاظ، فإن الله ينظر إلى القلوب وما أسرت، فإن وافقتها الألسنة فهى تبع لها، وإلا كان الدعاء لغوًا يبغضه الله تعالى. فالدعاء الدينى لا يتحقق إلا بإحساس الداعى بالحاجة إلى عناية الله تعالى، وعن هذا الإحساس يعبر اللسان بالضراعة والابتهال. فهذا التفسير ليس بأجنبى من سابقه. فتقلب الوجه فى السماء عبارة عن التوجه إلى الله تعالى انتظارًا لما كانت تشعر به روح النبى ﷺ وترجوه من نزول الوحى بتحويل القبلة.
ولا تدل الآية على أنه كان يدعو بلسانه طالبًا هذا التحويل ولا تنفى ذلك. وقال بعض المحققين: من كمال أدبه ﷺ أنه انتظر ولم يسأل. وهذا التوجه هو الذى يحبه الله تعالى ويهدى قلب صاحبه إلى ما يرجوه ويطلبه، لذلك قال عز وجل: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا}، أى فلنجعلنك متوليا قبلة تحبها وترضاها. وقرن الوعد بالأمر فقال: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} . تولية الوجه المكان أو الشىء هى جعله قبالته وأمامه، والتوالى عنه جعله وراءه. والشطر فى الأصل القسم المنفصل من الشىء. تقول: جعله شطرين، ومنه شطر البيت من الشعر وهو المصراع منه، وكذا المتصل كشطرى الناقة وأشطرها وهى أخلافها: شطران أماميان وشطران خلفيان. ويطلق على النحو والجهة وهو المراد هنا. فالواجب استقبال جهة الكعبة فى حال البعد عنها وعدم رؤيتها. ولا يجب استقبال عينها إلا على من يراها بعينه، أو يلمسها بيده أو بدنه. فإن صح إطلاق الشطر على عين الشىء فى اللغة فلا يصح أن يراد هـنا لمـا فيـه من الحـرج الشــديد لا سيما على الأمة الأمية.
ثم أمر بذلك المؤمنين عامة، فقال: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، أى وفى أى مكان كنتم فاستقبلوا جهته بوجوهكم فى صلاتكم، وهذا يقتضى أن يصلى المسلمون فى بقاع الأرض إلى جميع الجهات لا كالنصارى الذين يلتزمون جهة المشرق، ويقتضى أن يعرفوا موقعه البيت الحرام وجهته حيثما كانوا، ولذلك وضعوا علم سمت القبلة وتقويم البلدان (الجغرافية الفلكية والأرضية).
وقد عهد من أسلوب القرآن أن يكون الأمر يؤمر به النبى، أمرًا له وللمؤمنين به. فإذا أريد التخصيص جىء بما يدل عليه، كقوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ } (الإسراء: 79)، وقوله: { خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (الأحزاب: 50).
وإنما أمر الله المؤمنين فى هذه الآية بما أمر به النبى فيها نصا صريحا للتأكيد الذى اقتضته الحال فى حادثة القبلة، فإنها كانت حادثة كبيرة استتبعت فتنة عظيمة، فأراد الله أن يعلم المؤمنين بعنايته بها ويقررها فى أنفسهم، فأكد الأمر بها وشرفهم بالخطاب مع خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لتشتد قلوبهم وتطمئن نفوسهم، ويتلقوا تلك الفتنة التى أثارها المنافقون والكافرون بالحزم والثبات على الاتباع ولئلا يتوهم من سابق الكلام أنه خاص به عليه الصلاة والسلام.
بعد هذا، عاد إلى بيان حال السفهاء، مثيرى الفتنة فى مسألة تحويل القبلة، فقال: {وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ}، أى أن تولى المسجد الحرام هو الحق المنزل من الله على نبيه. وجمهور المفسرين على أن أكثر أولئك الفاتنين كانوا من أهل الكتاب المقيمين فى الحجاز، ولولا ذلك لم تكن الفتنة عظيمة؛ لأن كلام المشركين فى مسائل الوحى والتشريع قلما يلتفت إليه. وأما أهل الكتاب، فقد كانوا معروفين بين العرب بالعلم، ومن كان كذلك فإن عامة الناس تتقبل كلامه، ولو نطق بالمحال، لأن الثقة بمظهره تصد عن تمحيص خبره، فهو فى حاله الظاهرة شبهة إذا أنكر، وحجة إذا اعترف، ولأن الجماهير من الناس قد اعتادوا تقليد مثله من غير بحث ولا دليل.
وقد جرى أصحاب المظاهر العلمية والدينية على الانتفاع بغرور الناس بهم، فصار الغرض لهم من أقوالهم التأثير فى نفوس الناس، فهم يقولون ما لا يعتقدون لأجل ذلك، ويسندون ما يقولون إلى كتبهم كذبًا صريحًا أو تأويلاً بعيدًا. كما كان أحبار اليهود يطعنون فى النبى ﷺ وما جاء به، ويذكرون للناس أقوالاً على أنها من كتبهم وما هى من كتبهم، إن يريدون إلا خداعًا. وقد كذب الله هؤلاء الخادعين، وبيّن أنهم يقولون غير ما يعتقدون. كأنه يقول: إن هؤلاء قد قام عندهم الدليل على ما سبقت به بشارة أنبيائهم من صحة نبوة الرسول، ويعلمون أن أمر القبلة كغيرها من أمور الدين ما جاء به الوحى عن الله تعالى وأنه الحق لا محيص عنه، لا مكان معين بذاته، لذاته. {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ}، فهو المطلع على الظواهر والضمائر، الحسيب على ما فى السرائر، الرقيب على الأعمال، فيخبر نبيه بما شاء أن يخبره وإليه المرجع والمصير وعليه الحساب والجزاء. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى: «تعملون» بالتاء للخطاب.
سبق القول بأن النبى ﷺ كان حريصًا على هداية أهل الكتاب راجيًا بإيمانهم ما لا يرجوه من إيمان المشركين. فبمقدار حرصه ورجائه، كان يحزنه عروض الشُّبه لهم فى الدين، ويتمنى لو أعطى من الآيات والدلائل ما يمحو كل شبهة لهم. فلما كانت فتنة تحويل القبلة بمخادعتهم الناس، أخبره الله تعالى بأنهم غير مشتبهين فى الحق فتزال شبهتهم، وإنما هم قوم معاندون جاحدون على علم. ثم أعلمه بأن الآيات لا تؤثر فى المعاند ولا ترجع الجاحد عن غيه، فقال:
{وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ}، أى وتالله لئن جئتهم بكل آية على نبوتك وكل حجة على صدقك، ما تبعوا قبلتك فضلاً عن ملتك. فلا يحزنك قولهم ولا إعراضهم، ولا تحسبن الآيات والدلائل مقنعة أو صارفة لهم عن عنادهم، فهم قوم مقلدون لا نظر لهم ولا استدلال. وكما أيأسه من ابتاعهم قبلته أيأسهم من اتباعه قبلتهم، فقال: {وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ}، فإنك الآن على قبلة إبراهيم، الذى يجلونه جميعًا ولا يختلف فى حقيقة ملته أحد منهم، فهى الأجدر بالاجتماع عليها، وترك الخلاف إليها.
فإذا كان أتباع إبراهيم لا يزحزحهم عن تعصبهم لما ألفوا، وعنادهم فيما اختلفوا، وإذا كان التقليد يحول بينهم وبين النظر فى حقيقة معنى القبلة، وكون الجهات كلها لله تعالى، وأن الفائدة فيها الاجتماع دون الافتراق، فأى دليل أم آية ترجعهم عن قبلتهم؟! وأى فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها؟!
ألم ترى كيف اختلفوا هم فى القبلة، فجعل النصارى لهم قبلة غير قبلة اليهود التى كان عليها عيسى بعد موسى؟! {وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ} ، لأن كلاً منهم قد جمد بالتقليد على ما هو عليه. والمقلد لا ينظر فى آية ولا دليل، ولا فى فائدة ما هو فيه والمقارنة بينه وبين غيره؛ فهو أعمى لا يبصر، أصم لا يسمع، أغلف القلب لا يعقل.
{وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} . هذا الخطاب بهذا الوعيد لأعلى الناس مقامًا عند الله تعالى، هو أشد وعيد لغيره ممن يتبع الهوى، ويحاول استرضاء الناس بمجاراتهم على ما هم عليه من الباطل. فإنه أفرده بالخطاب، مع أن المراد به أمته – إذ يستحيل أن يتبع هو أهواءهم، أو أن يجاريهم على شىء نهاه الله تعالى عنه – ليتنبه الغافل، ويعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح هو من الظلم العظيم الذى يقطع طريق الحق، ويردى الناس فى مهاوى الباطل. كأنه يقول: إن هذا ذنب عظيم لا يتسامح فيه مع أحد، حتى لو فرض وقوعه من أكرم الناس على الله تعالى لسجل عليه الظلم، وجعله من أهله الذين صار وصفًا لازمًا لهم، {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}. فكيف حال من ليس له ما يقارب من مكانته عند ربه عز وجل؟!
نقرأ هذا التشديد والوعيد، ونسمعه من القارئين، ولا نزدجر عن اتباع أهواء الناس ومجاراتهم على بدعهم وضلالاتهم، حتى إنك ترى الذين يشكون من هذه البدع والأهواء، ويعترفون ببعدها عن الدين، يجارون أهلها عليها، ويمازجونهم فيها. وإذا قيل لهم فى ذلك، قالوا ماذا نعمل؟! ما فى اليد حيلة. العامة عمى. آخر زمان. وأمثال هذه الكلمات هى جيوش الباطل تؤيده وتمكنه فى الأرض، حتى يحل بأهله البلاء ويكونوا من الهالكين.
{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ}. ذكر فى الآية السابقة أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن ما جاء به النبى فى أمر القبلة هو الحق من ربهم، ولكنهم ينكرون ويمكرون. وذكر فى هذه ما هو الأصل والعلة فى ذلك العلم، وذلك الإنكار، وهو: أنهم يعرفون النبى ﷺ بما في كتبهم من البشارة به، ومن نعوته وصفاته التى لا تنطبق على غيره، وبما ظهر من آياته وآثار هدايته، كما يعرفون أبناءهم الذين يتولون تربيتهم وحياطتهم حتى لا يفوتهم من أمرهم شىء.
قال عبد الله بن سلام – °، وكان من علماء اليهود وأحبارهم: أنا أعلم به منى يا بنى؟ فقال له عمر، °: لم؟ قال: لأنى لست أشك فى محمد أنه نبى، فأما ولدى فلعل والدته خانت. فقد اعترف من هداه الله من أحبارهم، كهذا العالم الجليل وتميم الدارى من علماء النصارى، أنهم عرفوه ﷺ معرفة لا يتطرق إليها الشك.
{وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} إنه الحق الذى لا مرية فيه، فماذا يرجى منهم بعد هذا؟!
وذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير فى {يَعْرِفُونَهُ} لما ذكر من أمر القبلة، واستبعدوا عوده إلى الرسول مع تقدم ذكره فى الآيات، ومع ما يعهد من الاكتفاء بالقرائن فى مثل هذا التعبير. وقد أسند هذا الكتمان إلى فريق منهم إذ لم يكونوا كلهم كذلك، فإن منهم من اعترف بالحق وآمن واهتدى به، ومنهم من كان يجحده عن جهل ولو علم به لجاز أن يقبله، وهذا من دقة حكم القرآن على الأمم بالعدل.
ثم قال عز شأنه: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ}. الامتراء: الشك والتردد، وإنما يعرض لمن لا يعرفون الحق. والمعنى: أن هذا الذى أنت عليه أيها الرسول هو الحق – أو أن جنس الحق فى الدين هو الوحى – من عند ربك المعتنى بشأنك، فلا تلتفت إلى أوهام هؤلاء الجاحدين، فإنها لا تصلح شبهة على الحق الصريح الذى علمك الله فتمترى به.
والنهى فى هذه الآية، كالوعيد فى الآية السابقة: وجه الخطاب به إلى النبى ﷺ ، والمراد أمته، من كان منهم غير راسخ فى الإيمان، وخشى عليه الاغترار بمظاهر أولئك المخادعين الذي يغتر بأمثالهم الأغرار فى كل زمان ومكان، ولذلك ارتد بفتنة القبلة بعض ضعفاء الإيمان.