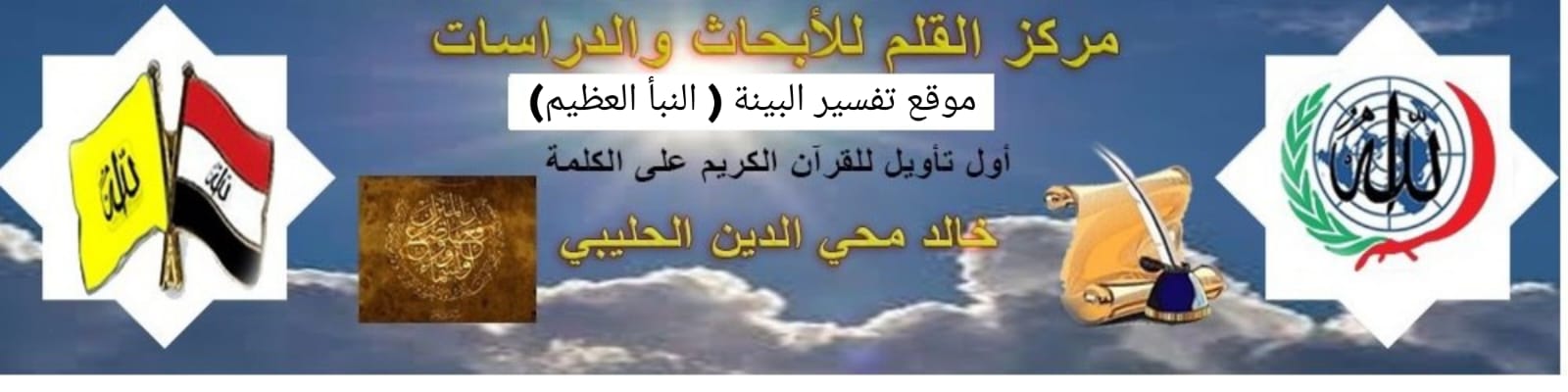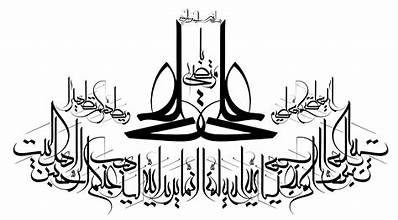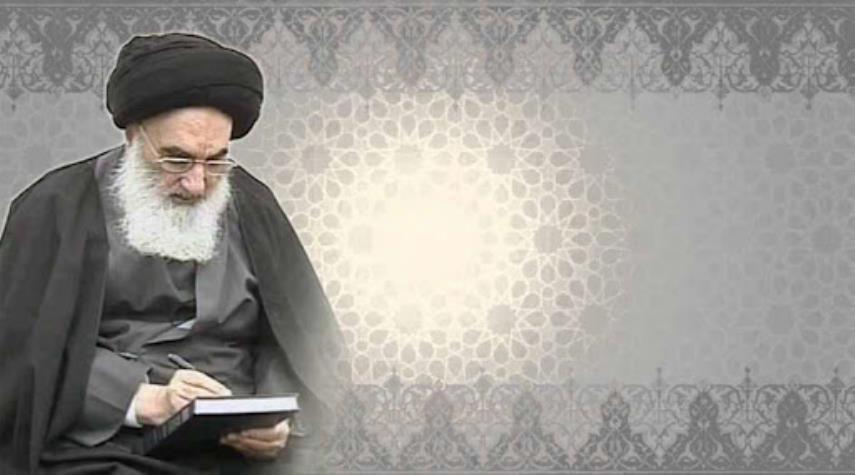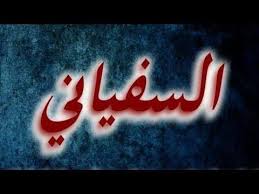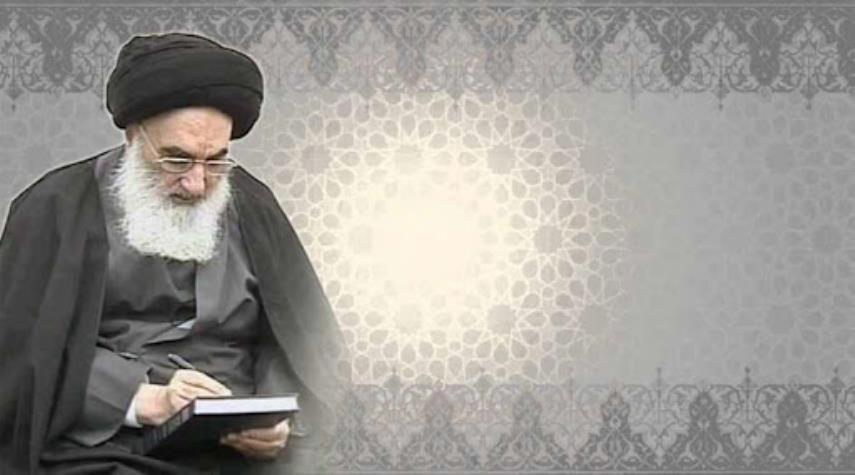موقع السيد السيستاني :
(مسألة 1243): النذر هو: أن يجعل الشخص لله على ذمّته فعل شيء أو تركه.
(مسألة 1244): لا ينعقد النذر بمجرّد النيّة، بل لا بُدَّ فيه من الصيغة.
ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال الناذر مثلاً: (لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو قال: (للرحمن عليّ أن أتصدّق بمائة دينار) صحّ النذر، وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّة لغة أخرى غير العربيّة. ولو اقتصر على قوله: (عليَّ كذا) لم ينعقد النذر وإن نوى في نفسه معنى (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله عليَّ نذر صوم) ففي انعقاده إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(مسألة 1245): يعتبر في الناذر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في متعلّق النذر، فيلغو نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً، وكذلك نذر المجنون – ولو كان أدواريّاً – حال جنونه، والمكره، والسكران، ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، والمفلس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفيه سواء تعلّق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمّته.
(مسألة 1246): يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل، فلا يصحّ نذر الحجّ ماشياً ممّن ليس له قدرة على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه.
وأمّا المباح فإن قصد به معنى راجحاً – كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً – انعقد نذره، وإلّا لم ينعقد.
كما ينحلّ فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، كما لو نذر ترك التدخين لتتحسّن صحّته ويقوى على خدمة الدين ثُمَّ ضرّه تركه.
(مسألة 1247): لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها. وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه – في غير الحجّ والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها – إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عمّا تعلّق به النذر فلم يعدّ بسببه راجحاً في حقّه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
(مسألة 1248): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة – كالمسجد – أو بصورة ثانويّة طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر – كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر – صحّ النذر، وإلّا لم ينعقد وكان لغواً.
(مسألة 1249): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أوّل كلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره.
(مسألة 1250): إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكميّة كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيّتها أو كمّيّتها كفته صلاة واحدة حتّى مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلى الله بشيء على وجه عامّ كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات.
(مسألة 1251): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفّارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنّه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنّى له الصيام بل يجوز له الإفطار والقضاء.
وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتّفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فيه دون موجب عمداً فعليه القضاء والكفّارة، وهي كفّارة حنث النذر الآتي بيانها.
(مسألة 1252): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقاً – أي قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة – لزمه تركه مدّة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً أثم ولزمته الكفّارة وقد بطل نذره، ولا إثم ولا كفّارة عليه فيما أتى به خطأً أو غفلةً أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً، ولا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذر.
(مسألة 1253): إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة، والأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله.
(مسألة 1254): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدّق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء.
وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) معيّناً فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه.
(مسألة 1255): من نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها، إلّا إذا كان ذلك مقصوداً له في نذره والتزامه.
(مسألة 1256): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد، فإن لم يتيسّر صرفه فيما ذكر وأشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرف في معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرّضوا لطارئ آخر.
(مسألة 1257): المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زوّاره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه إحياء ذكره ونحو ذلك.
(مسألة 1258): لو نذر التصدّق بشاة معيّنة – مثلاً – فنمت نموّاً متّصلاً كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً – كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن – فالنماء للناذر، إلّا إذا كان قاصداً للتعميم حين إنشاء النذر.
(مسألة 1259): إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره فتبيّن برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.
(مسألة 1260): إذا نذر الأب أو الأمّ تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن.
وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمكّن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزويجها منه لزمه ذلك، وإلّا فلا شيء عليه.
(مسألة 1244): لا ينعقد النذر بمجرّد النيّة، بل لا بُدَّ فيه من الصيغة.
ويعتبر في صيغة النذر اشتمالها على لفظ (لله) أو ما يشابهه من أسمائه المختصّة به، فلو قال الناذر مثلاً: (لله عليَّ أن آتي بنافلة الليل) أو قال: (للرحمن عليّ أن أتصدّق بمائة دينار) صحّ النذر، وله أن يؤدّي هذا المعنى بأيّة لغة أخرى غير العربيّة. ولو اقتصر على قوله: (عليَّ كذا) لم ينعقد النذر وإن نوى في نفسه معنى (لله)، ولو قال: (نذرت لله أن أصوم) أو (لله عليَّ نذر صوم) ففي انعقاده إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
(مسألة 1245): يعتبر في الناذر: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في متعلّق النذر، فيلغو نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً، وكذلك نذر المجنون – ولو كان أدواريّاً – حال جنونه، والمكره، والسكران، ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، والمفلس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفيه سواء تعلّق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمّته.
(مسألة 1246): يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر حين العمل، فلا يصحّ نذر الحجّ ماشياً ممّن ليس له قدرة على ذلك، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، كأن ينذر فعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه.
وأمّا المباح فإن قصد به معنى راجحاً – كما لو نذر أكل الطعام قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً – انعقد نذره، وإلّا لم ينعقد.
كما ينحلّ فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، كما لو نذر ترك التدخين لتتحسّن صحّته ويقوى على خدمة الدين ثُمَّ ضرّه تركه.
(مسألة 1247): لا يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقّه في الاستمتاع منها. وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه – في غير الحجّ والزكاة والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها – إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.
ويصح نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لا، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عمّا تعلّق به النذر فلم يعدّ بسببه راجحاً في حقّه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لا ينعقد مع سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
(مسألة 1248): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة – كالمسجد – أو بصورة ثانويّة طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر – كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر – صحّ النذر، وإلّا لم ينعقد وكان لغواً.
(مسألة 1249): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتى بالفعل قبله أو بعده لم يعتبر وفاءً، فمن نذر أن يتصدّق على الفقير إذا شفي من مرضه أو أن يصوم أوّل كلّ شهر، ثُمَّ تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره.
(مسألة 1250): إذا نذر صوماً ولم يحدّده من ناحية الكميّة كفاه صوم يوم واحد، وإذا نذر صلاة من دون تحديد كيفيّتها أو كمّيّتها كفته صلاة واحدة حتّى مفردة الوتر، وإذا نذر صدقة ولم يحدّدها نوعاً وكمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، وإذا نذر التقرّب إلى الله بشيء على وجه عامّ كان له أن يأتي بأيّ عمل قربي كالصوم أو الصدقة أو الصلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل ونحو ذلك من طاعات وقربات.
(مسألة 1251): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له أن يسافر في ذلك اليوم ولو من غير ضرورة فيفطر ويقضيه ولا كفّارة عليه، وكذلك إذا جاء عليه اليوم وهو مسافر فإنّه لا يجب عليه قصد الإقامة ليتسنّى له الصيام بل يجوز له الإفطار والقضاء.
وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتّفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه، أمّا إذا أفطر فيه دون موجب عمداً فعليه القضاء والكفّارة، وهي كفّارة حنث النذر الآتي بيانها.
(مسألة 1252): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، وإذا نذر تركه مطلقاً – أي قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة – لزمه تركه مدّة حياته، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامداً أثم ولزمته الكفّارة وقد بطل نذره، ولا إثم ولا كفّارة عليه فيما أتى به خطأً أو غفلةً أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً، ولا يبطل بذلك نذره فيجب الترك بعد ارتفاع العذر.
(مسألة 1253): إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به لم يخرج ذلك المقدار من أصل التركة، والأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراجه من حصصهم والتصدّق به من قبله.
(مسألة 1254): إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدّق بها على غيره، وإذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر لم يلزمه شيء.
وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) معيّناً فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره، وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شيء عليه.
(مسألة 1255): من نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها، إلّا إذا كان ذلك مقصوداً له في نذره والتزامه.
(مسألة 1256): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً يصرف في مصالحه، فينفق منه على عمارته أو إنارته أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد، فإن لم يتيسّر صرفه فيما ذكر وأشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرف في معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرّضوا لطارئ آخر.
(مسألة 1257): المال المنذور لشخص صاحب المشهد من دون أن يقصد الناذر له مصرفاً معيّناً يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كأن ينفق على زوّاره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه إحياء ذكره ونحو ذلك.
(مسألة 1258): لو نذر التصدّق بشاة معيّنة – مثلاً – فنمت نموّاً متّصلاً كالسمن كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها، وإذا نمت نموّاً منفصلاً – كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن – فالنماء للناذر، إلّا إذا كان قاصداً للتعميم حين إنشاء النذر.
(مسألة 1259): إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره فتبيّن برء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.
(مسألة 1260): إذا نذر الأب أو الأمّ تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن.
وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمكّن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزويجها منه لزمه ذلك، وإلّا فلا شيء عليه.
النذر ـ اليمين ـ العهد » أحكام اليمين
(مسألة 1261): اليمين على ثلاثة أنواع:
1- ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه في الماضي أو الحال أو الاستقبال. والأيمان من هذا النوع إمّا صادقة وإمّا كاذبة.
والأيمان الصادقة ليست محرّمة ولكنّها مكروهة بحدّ ذاتها، فيكره للمكلّف أن يحلف على شيء صدقاً أو أن يحلف على صدق كلامه.
وأمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس وهي: اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى.
ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إذا التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها ومتيسّرة له فالأحوط وجوباً أن يورّي في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضّحة لقصده، فمثلاً: إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه وأين هو؟ يقول: (ما رأيته) فيما إذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد أنّه لم يره منذ دقائق.
2- ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حثّ المسؤول على إنجاح المقصود، ويسمّى بـ «يمين المناشدة»، كقول السائل: (أسألك بالله أن تعطيني ديناراً).
واليمين من هذا النوع لا يترتّب عليها شيء من إثم ولا كفّارة لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.
3- ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، ويسمّى: «يمين العقد»، كقوله: (والله لأصومنّ غداً) أو (والله لأتركنّ التدخين).
وهذه اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء بها، وتترتّب على حنثها الكفّارة، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيّام متواليات. واليمين من هذا النوع هي الموضوع للمسائل الآتية.
(مسألة 1262): يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرّف في متعلّق اليمين نظير ما تقدّم في النذر.
(مسألة 1263): لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة من الأخرس، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز عن التكلّم، بل لا يترك الاحتياط في الكتابة من غيره.
(مسألة 1264): لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المحلوف به هو الذات الإلهيّة، سواء بذكر اسمه المختصّ به كلفظ الجلالة (الله) وما يلحقه كلفظ (الرحمن)، أو بذكر وصفه أو فعله المختصّ به الذي لا يشاركه فيه غيره كـ (مقلّب القلوب والأبصار) و(الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة)، أو بذكر وصفه أو فعله الذي يغلب إطلاقه عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره، بل يكفي ذكر فعله أو وصفه الذي لا ينصرف إليه في حدّ نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كـ (الحيّ) و(السميع) و(البصير).
وإذا كان المحلوف به بعض الصفات الإلهيّة أو ما يلحق بها – كما لو قال: (وحقّ الله) أو (بجلال الله) أو (بعظمة الله) – لم تنعقد اليمين إلّا إذا قصد ذاته المقدّسة.
(مسألة 1265): لا يحرم الحلف بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وسائر النفوس المقدّسة والقرآن الشريف والكعبة المعظّمة وسائر الأمكنة المحترمة، ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها، ولا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفّارة.
(مسألة 1266): يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثُمَّ عجز عنه المكلّف – لا لتعجيز نفسه – فإن كان معذوراً في تأخيره ولو لاعتقاد قدرته عليه لاحقاً انحلّت يمينه، وإلّا أثم ووجبت عليه الكفّارة.
ويلحق بالعجز فيما ذكر الضرر الزائد على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل أو الترك والحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة فإنّه تنحلّ اليمين بهما.
(مسألة 1267): تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب والمستحبّ وترك الحرام والمكروه، وتنعقد أيضاً إذا كان متعلّقها راجحاً بحسب الأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة للحالف بشرط أن لا يكون تركه راجحاً شرعاً.
وكما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها مرجوحاً كذلك تنحلّ فيما إذا تعلّقت براجح ثُمَّ صار مرجوحاً، كما لو حلف على ترك التدخين أبداً ثُمَّ ضرّه تركه بعد حين، فإنّه تنحلّ يمينه حينئذٍ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها.
(مسألة 1268): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج.
ولا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد والزوج، فلو حلف الولد أو الزوجة ولم يطّلعا على حلفهما أو لم يمنعا مع علمهما به صحّ حلفهما ووجب الوفاء به.
(مسألة 1269): إذا ترك المكلّف الوفاء بيمينه نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً أو عن جهل يعذر فيه لم تجب عليه الكفّارة، مثلاً: إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً ثُمَّ منعه وسواسه عن ذلك، فلا شيء عليه إذا كان الوسواس بالغاً إلى درجة يسلبه الاختيار، وإلّا لزمته الكفّارة.
1- ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه في الماضي أو الحال أو الاستقبال. والأيمان من هذا النوع إمّا صادقة وإمّا كاذبة.
والأيمان الصادقة ليست محرّمة ولكنّها مكروهة بحدّ ذاتها، فيكره للمكلّف أن يحلف على شيء صدقاً أو أن يحلف على صدق كلامه.
وأمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغموس وهي: اليمين الكاذبة في مقام فصل الدعوى.
ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عن نفسه أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إذا التفت إلى إمكان التورية وكان عارفاً بها ومتيسّرة له فالأحوط وجوباً أن يورّي في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضّحة لقصده، فمثلاً: إذا حاول الظالم الاعتداء على مؤمن فسأله عن مكانه وأين هو؟ يقول: (ما رأيته) فيما إذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد أنّه لم يره منذ دقائق.
2- ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حثّ المسؤول على إنجاح المقصود، ويسمّى بـ «يمين المناشدة»، كقول السائل: (أسألك بالله أن تعطيني ديناراً).
واليمين من هذا النوع لا يترتّب عليها شيء من إثم ولا كفّارة لا على الحالف في إحلافه ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.
3- ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في المستقبل، ويسمّى: «يمين العقد»، كقوله: (والله لأصومنّ غداً) أو (والله لأتركنّ التدخين).
وهذه اليمين هي التي تنعقد عند اجتماع الشروط الآتية ويجب الوفاء بها، وتترتّب على حنثها الكفّارة، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيّام متواليات. واليمين من هذا النوع هي الموضوع للمسائل الآتية.
(مسألة 1262): يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرّف في متعلّق اليمين نظير ما تقدّم في النذر.
(مسألة 1263): لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما هو بمثابته كالإشارة من الأخرس، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز عن التكلّم، بل لا يترك الاحتياط في الكتابة من غيره.
(مسألة 1264): لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المحلوف به هو الذات الإلهيّة، سواء بذكر اسمه المختصّ به كلفظ الجلالة (الله) وما يلحقه كلفظ (الرحمن)، أو بذكر وصفه أو فعله المختصّ به الذي لا يشاركه فيه غيره كـ (مقلّب القلوب والأبصار) و(الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة)، أو بذكر وصفه أو فعله الذي يغلب إطلاقه عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره، بل يكفي ذكر فعله أو وصفه الذي لا ينصرف إليه في حدّ نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كـ (الحيّ) و(السميع) و(البصير).
وإذا كان المحلوف به بعض الصفات الإلهيّة أو ما يلحق بها – كما لو قال: (وحقّ الله) أو (بجلال الله) أو (بعظمة الله) – لم تنعقد اليمين إلّا إذا قصد ذاته المقدّسة.
(مسألة 1265): لا يحرم الحلف بالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) وسائر النفوس المقدّسة والقرآن الشريف والكعبة المعظّمة وسائر الأمكنة المحترمة، ولكن لا تنعقد اليمين بالحلف بها، ولا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفّارة.
(مسألة 1266): يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها، فلو كان مقدوراً حين اليمين ثُمَّ عجز عنه المكلّف – لا لتعجيز نفسه – فإن كان معذوراً في تأخيره ولو لاعتقاد قدرته عليه لاحقاً انحلّت يمينه، وإلّا أثم ووجبت عليه الكفّارة.
ويلحق بالعجز فيما ذكر الضرر الزائد على ما يقتضيه طبيعة ذلك الفعل أو الترك والحرج الشديد الذي لا يُتحمّل عادة فإنّه تنحلّ اليمين بهما.
(مسألة 1267): تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب والمستحبّ وترك الحرام والمكروه، وتنعقد أيضاً إذا كان متعلّقها راجحاً بحسب الأغراض العقلائيّة الدنيويّة أو مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة للحالف بشرط أن لا يكون تركه راجحاً شرعاً.
وكما لا تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها مرجوحاً كذلك تنحلّ فيما إذا تعلّقت براجح ثُمَّ صار مرجوحاً، كما لو حلف على ترك التدخين أبداً ثُمَّ ضرّه تركه بعد حين، فإنّه تنحلّ يمينه حينئذٍ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها.
(مسألة 1268): لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج.
ولا يعتبر في انعقاد يمينهما إذن الوالد والزوج، فلو حلف الولد أو الزوجة ولم يطّلعا على حلفهما أو لم يمنعا مع علمهما به صحّ حلفهما ووجب الوفاء به.
(مسألة 1269): إذا ترك المكلّف الوفاء بيمينه نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً أو عن جهل يعذر فيه لم تجب عليه الكفّارة، مثلاً: إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً ثُمَّ منعه وسواسه عن ذلك، فلا شيء عليه إذا كان الوسواس بالغاً إلى درجة يسلبه الاختيار، وإلّا لزمته الكفّارة.
النذر ـ اليمين ـ العهد » احكام العهد
(مسألة 1270): لا ينعقد العهد بمجرّد النيّة بل يحتاج إلى الصيغة، فلا يجب العمل بالعهد القلبي وإن كان ذلك أحوط استحباباً. وصيغة العهد أن يقول: (عاهدتُ الله) أو (عليَّ عهدُ الله أن أفعل كذا) أو (…أترك كذا).
(مسألة 1271): يعتبر في منشئ العهد: أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرّف في متعلّق العهد على حذو ما تقدّم اعتباره في النذر واليمين.
(مسألة 1272): لا يعتبر في متعلّق العهد أن يكون راجحاً شرعاً كما مرّ اعتباره في متعلّق النذر، بل يكفي أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيويّة العقلائيّة أو مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة مثل ما مرّ في متعلّق اليمين.
(مسألة 1273): إذا أنشأ العهد مطلقاً – أي غير مُعلّق على تحقّق أمرٍ – وجب الوفاء به على أيّ حال، وإذا أنشاه مُعلّقاً على قضاء حاجته – مثلاً – كما لو قال: (عليَّ عهد الله أن أصوم يوماً إذا برئ مريضي) وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته.
ومتى خالف المكلّف عهده بعد انعقاده لزمته الكفّارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً.
(مسألة 1271): يعتبر في منشئ العهد: أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرّف في متعلّق العهد على حذو ما تقدّم اعتباره في النذر واليمين.
(مسألة 1272): لا يعتبر في متعلّق العهد أن يكون راجحاً شرعاً كما مرّ اعتباره في متعلّق النذر، بل يكفي أن لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيويّة العقلائيّة أو مشتملاً على مصلحة دنيويّة شخصيّة مثل ما مرّ في متعلّق اليمين.
(مسألة 1273): إذا أنشأ العهد مطلقاً – أي غير مُعلّق على تحقّق أمرٍ – وجب الوفاء به على أيّ حال، وإذا أنشاه مُعلّقاً على قضاء حاجته – مثلاً – كما لو قال: (عليَّ عهد الله أن أصوم يوماً إذا برئ مريضي) وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته.
ومتى خالف المكلّف عهده بعد انعقاده لزمته الكفّارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً.
رابط :
https://www.sistani.org/arabic/book/13/687/