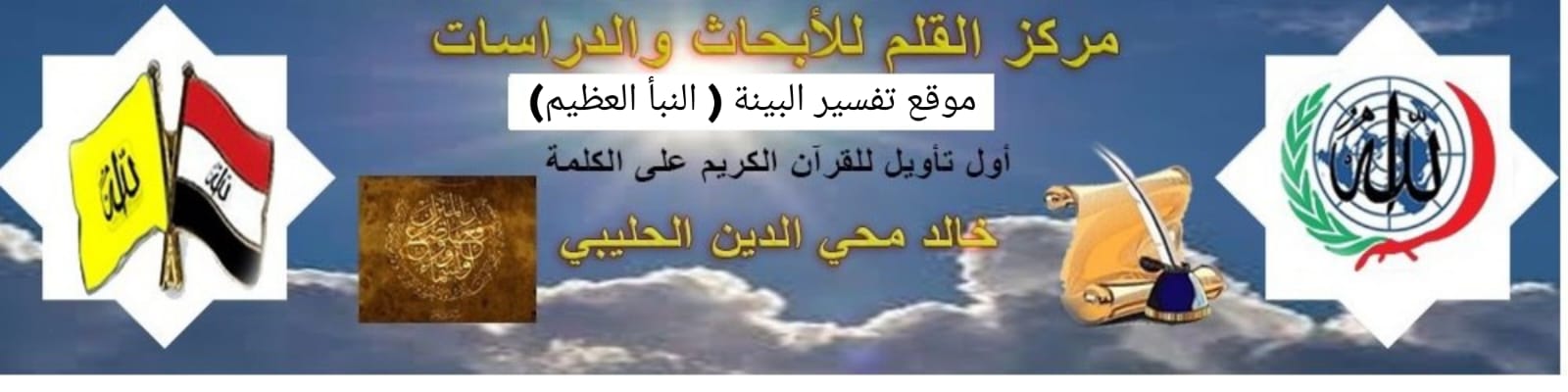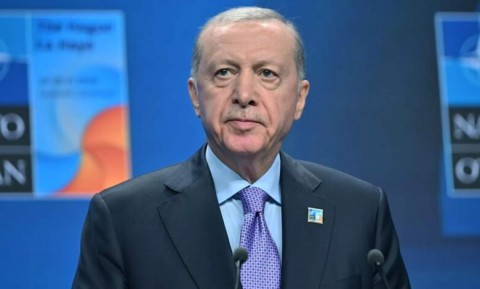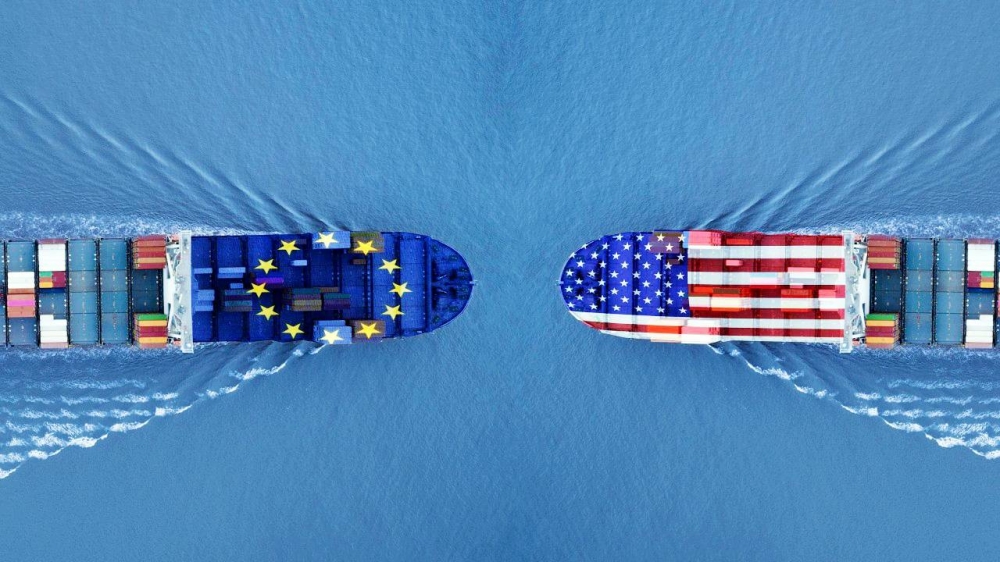بقلم : أشرف راضي :
صحفي ومحلل سياسي :
لا توجد دولة في العالم لم تتأثر بالحرب الدائرة في العالم، ولا يوجد ركن في العالم لا ينشغل بهذه الحرب وتطوراتها وانعكاساتها التي تتجاوز أوكرانيا إلى مناطق بعيدة في العالم، الأمر الذي يجعل هذه الحرب وبحق لحظة فارقة في تاريخ البشرية الحديث والمعاصر، وسيتحدد بعد نهاية المعارك والتوصل لتسوية شكل الترتيبات الدولية الجديدة على كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
وبينما ينشغل المحللون بتفسير ما يجري على الأرض ويحاولون جاهدين وضع سيناريوهات للمستقبل ينشغل الساسة في أنحاء العالم بالسعي للتأثير في مجريات الأمور لتأمين مكان في الترتيبات التي ستتمخض عنها تلك الحرب، واستعدادا لكل الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة. وبينما يتحدث بعض المتابعين للحرب بدرجة كبيرة من الثقة واليقين عما ستنتهي إليه تلك الحرب، نجد الساسة أكثر حذرا في السير وراء هذه الآراء ويعدلون من مواقفهم وفق التطورات والتقديرات الفعلية ولا ينطلقون من الأماني ولا التصورات التي تعبر عن انحياز أيديولوجي لهذا الطرف أو ذاك من الأطراف المنخرطة في الصراع حول أوكرانيا، والمنخرطة كذلك في الصراع الدولي الأوسع من أجل المصالح والمكانة.
على ماذا تدور الحرب في أوكرانيا؟
على الرغم من أهمية أوكرانيا بالنسبة للمصالح الجيوسياسية والاستراتيجية لروسيا، لكن ثمة اتفاق واسع بين المراقبين على أن أهداف هذه الحرب تتجاوز أوكرانيا، فعلى أرض أوكرانيا تدور حرب مدمرة ودامية حول الترتيبات الدولية الجديدة، مثلما كانت حرب العراق عام 1991، لكن مع وجود فروق واضحة بين الوضع الدولي. ففي عام 1991، كان العراق في مواجهة إرادة دولية موحدة ضد غزوه الكويت، ولم يفلح الانقسام على المستوى الإقليمي في منع استصدار قرارات من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد العراق، ولم يحظ العراق ولا الدول الإقليمية المتحالفة معه بأي غطاء دولي.
والآن وبعد مرور أكثر من 30 عاما على حرب الكويت، حدثت تطورات جديدة على الساحة الدولية مع تراجع لحظة الهيمنة الأمريكية على الشؤون الدولية وتحطم أحلام الإمبراطورية الأمريكية على صخور الواقع المرير، رغم التفوق الأمريكي عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا على القوى المنافسة، ورغم هيمنتها على حلف شمال الأطلسي وعلى التحالفات العسكرية التي تشكلت استجابة لبعض التحديات. كذلك تدور الحرب الأوكرانية بين أقطاب متنافسة ومتصارعة على مدى العقود الثلاث الماضية، ومن ثم تطرح هذه الأقطاب تحديات جدية أمام نفوذ الولايات المتحدة وهيمنتها.
يمكن القول أن هناك مستويين للحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، مترابطان ويؤثر كل منهما في الآخر. فمن ناحية، هناك مستو مباشر يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني وسياسات روسيا في الجوار القريب، وهناك من ناحية أخرى، مستو غير مباشر يتعلق بالأبعاد التي تتجاوز حدود أوكرانيا وتشمل قوى عالمية أخرى، وهو المستوى المتعلق بترتيب الوضع الدولي والصراع على النفوذ العالمي، سواء على المسرح العالمي أو على مسارح إقليمية، وفي مقدمتها أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
وعلى المستويين، تدور الحرب في أوكرانيا بين نموذجين وتصورين للسياسات الداخلية والسياسية العالمية. النموذج الأول، الذي تدافع عنه الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون، يقوم على أساس الدفاع عن الديمقراطية كأسلوب للحكم وإدارة شؤون الدول، وتميل أمريكا وحلفاؤها أكثر إلى نموذج الديمقراطية الليبرالية، وتتسامح إلى حد ما مع التيارات الشعبوية، خصوصا اليمينية التي تصل للحكم عبر صناديق الانتخابات، لاسيما في الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، رغم ما تمثله تلك التوجهات من تهديد للديمقراطية الليبرالية. في المقابل، ترفض روسيا والصين وكثير من الحكومات التي جاءت للسلطة عبر انقلابات أو نتيجة لانتخابات لا تحظى بأي قدر من المصداقية في الداخل النموذج الأمريكي والغربي للديمقراطية التي لا تناسب مجتمعاتها، وتشير إلى أن للديمقراطية نماذج أخرى ويتهمون الولايات المتحدة والغرب بالسعي للتدخل في شؤون الدول الأخرى برفع شعارات زائفة للديمقراطية.
ودون الدخول في مناقشة حجج الطرفين ولا أي النموذجين أصلح، فمن الملاحظ أن الصراع حول النموذجين يتجاوز ساحة الحرب في أوكرانيا والنخب الحاكمة إلى الشعوب والمجتمعات. فالرأي العام حول الحرب الأوكرانية منقسم في كثير من دول العالم، ويميل مناصرو الديمقراطية في كثير من العواصم والمدن الكبرى إلى مناصرة الرئيس الأوكراني وصمود أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي وأهدافه المعلنة. وينفر هؤلاء بشكل عام من فكرة استخدام القوة المسلحة لفرض إرادة طرف على الآخرين ويعارضون ذلك بشدة على النحو الذي رأيناه في المظاهرات التي خرجت في العديد من المدن ضد الغزو الروسي. بينما يميل خصوم الولايات المتحدة والقيم الغربية، سواء من اليسار الاشتراكي بتنويعاته المختلفة أو من الإسلاميين والقوميين، لتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويرون أن هناك مبررات مشروعة لغزوه لأوكرانيا ولحملته العسكرية ضد حكومتها الموالية للغرب. هذا الانقسام يطول أيضا روسيا والصين على نحو ما يتضح من موقف كثير من المواطنين الناطقين بالروسية في إقليم الدونباس في شرق أوكرانيا خارج المنطقتين الخاضعتين للانفصاليين اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا. وليس موقف الصينيين في تايوان أو هونج كونج ببعيد عن هذا الصراع بين المتطلعين لنظام ديمقراطي وبين الوطنيين الصينيين الرافضين للديمقراطية الغربية.
يرتبط بهذا الانقسام حول الديمقراطية انقسام آخر للصراع بين المثل والقيم الإنسانية العالمية من جهة وبين السياسة الواقعية. وهو انقسام لا يقتصر فقط على المستوى الأكاديمي بين مدرستين في العلاقات الدولية وإنما بات يؤثر في مواقف كثير من القطاعات والقوى الاجتماعية والنخب الثقافية في أنحاء العالم. فمن وجهة نظر المثل والقيم الإنسانية، فإن العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا وما سببه من أزمة إنسانية مدان بكل المقاييس. وتقف منظمات المجتمع المدني في البلدان المختلفة في طليعة القوى التي تدافع عن المثل والقيم الإنسانية، لكن الملاحظ أيضا تصاعد الأصوات التي تنتقد ازدواجية المعايير الأوروبية في التعامل مع اللاجئين الأوكرانيين واللاجئين من إفريقيا والبلدان العربية ودول العالم الثالث، التي تتبناها كثير من حكومات الدول الأوروبية. ومن المهم هنا الالتفات إلى أن هذه القوى المدنية لا تكتفي بالتنديد وإنما تتحرك لتقديم المساعدة على الأرض، على نحو ما نشهده من إنقاذ للمهاجرين من إفريقيا ودول الشرق الأوسط في قوارب في البحر المتوسط والضغط على دول أوروبية لاستقبالهم. وإن كان أنصار السياسة الواقعية يتفقون في رفض استخدام القوة لفرض الإرادة إلا أنهم لا يتوقفون في نقدهم عند روسيا أو القوى غير الغربية وإنما ينتقدون أيضا سياسات الحرب التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفائها، كما أنهم يسعون للبحث في الأسباب التي أدت إلى نشوب الحرب سعيا للتوصل إلى تسويات تراعي مصالح الأطراف المختلفة وتستند إلى توازنات للقوة والمصالح وأيضا لقدر من المعايير الدولية.
ويرتبط بالانقسام الثاني بين المثل والسياسة الواقعية، انقسام بين تيارين كبيرين يتصارعان على شكل الترتيبات الدولية الذي يحقق استقرارا في العلاقات الدولية، ولكل منهما تواجد على الساحتين الداخلية والدولية، وتوجد عدة أجنحة داخل كل تيار. من ناحية، هناك تيار ما يسمى بالنظام العالمي الذي يتعين على القوى التي خرجت منتصرة من الحرب الباردة، الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي والقوى الحليفة في آسيا فرضه من خلال المؤسسات الدولية القائمة أو المنظمات الناشئة، مثل منظمة التجارة العالمية أو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأمنية والعسكرية والخاصة بحيازة أسلحة الدمار الشامل. ويقوم المنطق العام على هذا التيار على فكرتين متناقضتين: الأولى هي تقييد قدرة الدول خارج هذا المعسكر على شن الحرب، من خلال تحجيم قدراتها العسكرية، والثانية هي إطلاق القدرة على شن الحرب للقوى المنضوية تحت لواء هذا المعسكر وتوسيع حلفها العسكري بضم دول أخرى وزيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء من أجل تعزيز القدرات العسكرية للحلف لضمان الانتصار في أي مواجهة عسكرية متوقعة أو متخيلة. وجرى تطوير العقيدة العسكرية ووسائل استخدام القوة لدى هذا المعسكر الذي خاض عددا من الحروب والحملات العسكرية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ووسع من أشكال ومستويات استخدام القوة المسلحة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في سياق “الحرب على الإرهاب” التي كادت أن تكون حربا عالمية داخل الدول وفيما بينها.
ولا يحول التوافق في الرؤية العامة والتوجه الاستراتيجي في هذا المعسكر دون وجود تنافس اقتصادي وتكنولوجي شرس فيما بين أعضائه ومراقبة دقيقة لتوازن القوى فيما بينهم وتخوض تلك القوى الصراعات فيما بينها بوسائل غير قتالية وغير عسكرية.
التيار الثاني، يرى أن الشكل الأمثل للترتيبات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة هو الإقرار بحقيقة أننا نعيش في عالم متعدد الأقطاب من ناحية وأن هذه التعددية القطبية تقوم على حقيقة التداخل الشديد بين المصالح والاعتماد المتبادل ويعارض هذا التيار السياسات الأحادية ويدافع عن الأطر والهياكل متعددة الأطراف، ويعارض أيضا سياسة فرض العقوبات التي جرى التوسع فيها إلا في ظل وجود انتهاكات صارخة للمعايير والقوانين والقيم الدولية على غرار ما حدث في النظام العنصري في جنوب أفريقيا وإيران وكوريا الشمالية بسبب انتهاك اتفاقية منع الانتشار النووي والعراق بسبب غزو الكويت فضلا عن عقوبات جزئية في قضايا محددة، مثل الامتناع عن الانضمام لاتفاقية الحظر الشامل للأسلحة البيولوجية والكيماوية.
ويقف التياران بأجنحتهما المختلفة في مواجهة حاسمة في الحرب في أوكرانيا. وستحدد نتيجة الحرب والكيفية التي سيحسم بها الصراع شكل الترتيبات الدولية، كما سيحددها أيضا التفاعلات فيما بين الأجنحة داخل كل تيار.
وإذا كلن انتهاء العالم أحادي القطبية والأحلام الإمبراطورية هو الاحتمال الأكثر ترجيحا في ظل التوازنات البازغة في العقد الأخير وفي ضوء نوع المخاطر التي تهدد دول العالم بسبب التغيرات المناخية والأوبئة والجوائح على النحو الذي شهدناه مع فيروس كورونا وموجاته، فإن الخلاف، أو بالأحرى الصراع، يدور الآن حول كيفية انتظام الأقطاب وما هو شكل الترتيب العالمي الناجم. هل سنشهد عودة لنظام القطبية الثنائية بين معسكرين لكل منهما قيادة واضحة وهيكل محدد لتوزيع القوى وتقاسم الأعباء وتوحيد الأهداف، أما أننا سنكون بصدد عالم متعدد الأقطاب تنشأ فيما بينها تحالفات حول عدد من القضايا وتنفض ولا تكون مواقف الدول متطابقة تماما رغم وجود محددات عامة لوجود معسكرين بداخل كل منهما أقطاب مستقلة وتظل التحالفات فيما بين أقطاب من المعسكرين مقيدة بشدة ومحددة الهدف.
وإلى الآن لا نعرف كيف سيكون شكل التفاعلات في المعسكر الغربي مع صعود القوة الألمانية والقوة اليابانية وتغيير أوضاع ما بعد الحرب العالمية الثانية، أو كيف ستصبح الانقسامات مع صعود قوى اليمين المتطرف وتيار الشعبوية اليميني للحكم في تلك الدول من خلال صناديق الانتخاب. وكيف ستؤثر على التغيرات على أوضاع دول العالم الثالث التي بدأت تتفاقم مع بدء الحرب في أوكرانيا.
المهم أن هذه التطورات مرهونة بعاملين أساسيين:
الأول :
هو عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا ودخول أطراف أخرى، وما قد ينطوي عليه ذلك من تصعيد في استخدام القوة المسلحة واستخدام القدرات النووية الاستراتيجية وما قد تلحقه هذه القدرات من دمار لمناطق كاملة في العالم،.
والثاني :
هو عدم نشوب صراعات إقليمية أخرى متزامنة مع هذه الحرب وهو الأمر الذي يزيد من رقعة الصراع ومن الانقسامات الدولية. وفي الحالتين سنكون أمام وضع دولي وأوضاع داخلية جديدة تماما ولا يعرف من سيستطيع إعادة بناء أي كيانات سياسية فيما سيتبقى من العالم وفي ظل أي شروط وأوضاع. الأمر المؤكد في هذه اللحظة هو الحرص الشديد من قبل الأطراف لعدم التصعيد وممارسة درجات من ضبط النفس مع تكثيف الجهود من أجل إيجاد مخرج وحل دبلوماسي للحرب والأزمة..
يبقى سؤال رئيسي حول انعكاس هذه التسوية على أوضاعنا هنا في منطقة الشرق الأوسط وحول القيود والفرص المتاحة في ظل كل سيناريو من هذه السيناريوهات؟ والإجابة على هذا السؤال تستحق أن يفرد لها مقال آخر.
بقلم
صحفي ومحلل سياسي
أشرف راضي