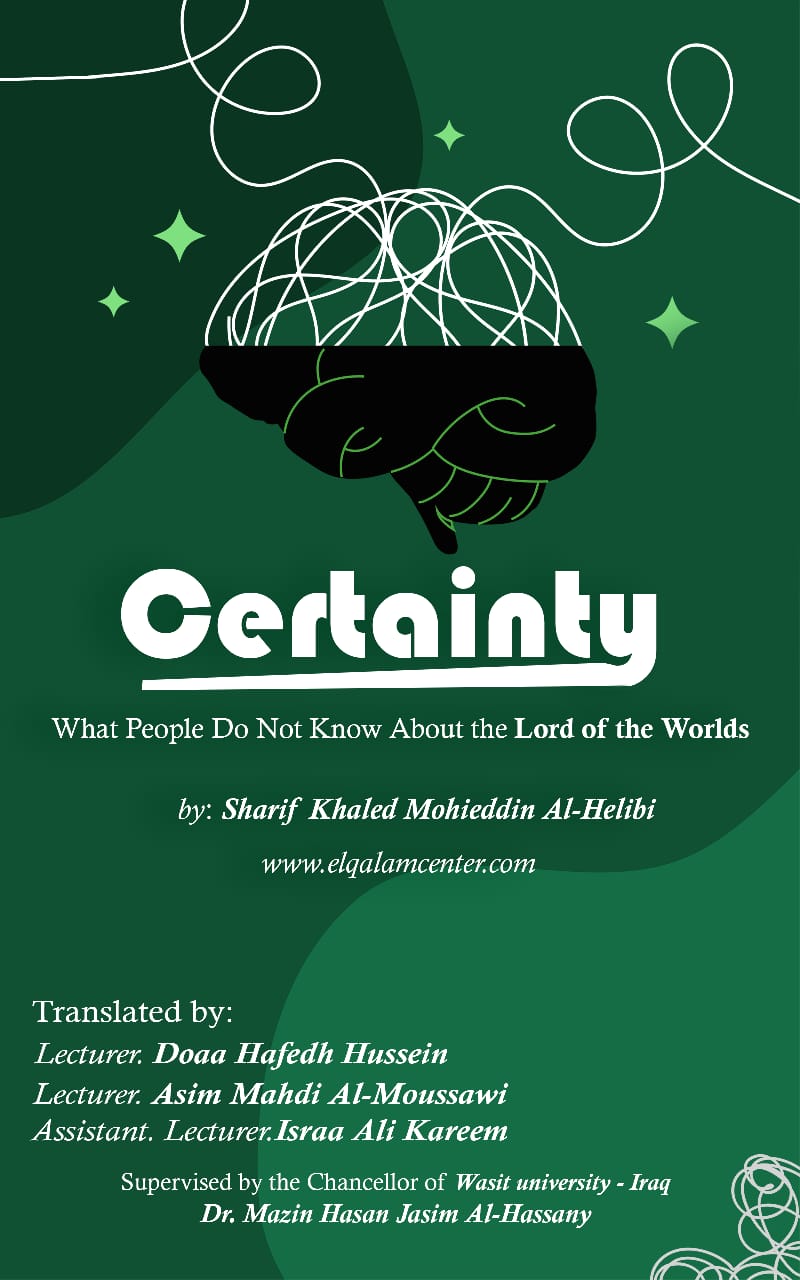الخليج الجديد :
منذ الإعلان عن فوز “جو بايدن” في انتخابات الرئاسة الأمريكية، سادت حالة من القلق وعدم الارتياح في مصر، حيث سيفقد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” الآن صديقا موثوقا به في واشنطن، وهو نظيره الأمريكي “دونالد ترامب”، الذي سبق أن وصف “السيسي” بأنه “ديكتاتوره المفضل”.
ولا ينبع قلق مصر من فقدان “السيسي” حليفا مهما في البيت الأبيض فحسب، بل أيضا من انتقادات الإدارة القادمة لوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر.
والسؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت العلاقة المصرية الأمريكية ستخضع لتغييرات كبيرة في ظل إدارة “بايدن” أم ستبقى كما كانت خلال العقود الأربعة الماضية؟
علاقة استراتيجية وتوترات متفرقة
ومنذ أواخر السبعينات، كانت مصر واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وباعتبارها الدولة العربية صاحبة أكبر عدد من السكان، والدولة التي تتمتع بنفوذ سياسي وثقافي كبير في جميع أنحاء المنطقة، تظل مصر لاعبا رئيسيا تحرص أي إدارة أمريكية على الحفاظ على علاقة قوية معها.
وتسيطر مصر أيضا على قناة السويس، وهي طريق الشحن العالمي المهم الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر.
علاوة على ذلك، تعززت العلاقة بين القاهرة وواشنطن بعد أن وقعت مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وفي الواقع، جاء الجزء الأكبر من 84 مليار دولار من المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لمصر بعد عام 1979، ومعظم ذلك في شكل مساعدات عسكرية.
وفي عام 2021، من المقرر أن تتلقى مصر 1.4 مليار دولار من المساعدات الأمريكية، وساهمت هذه المساعدات في إبقاء نظام الرئيس “حسني مبارك” في السلطة حتى الإطاحة به بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وهي ضرورية الآن أيضا للحفاظ على نظام “السيسي”.
ويشمل التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة مجالات متعددة، ولكنه بارز بشكل خاص في مجالات الأمن والدفاع والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
وربما يكون موقع مصر كشريك رئيسي للولايات المتحدة في هذه المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية هو ما يفسر أهميتها بالنسبة لواشنطن كحليف إقليمي، وهذا ما يفسر القلق الأمريكي المستمر على استقرار مصر.
كما تلعب العلاقة بين مصر وإسرائيل دورا مهما في تعزيز التحالف مع واشنطن، وبما أن البلدين لم يشهدا أي حروب منذ توقيع اتفاق السلام عام 1979، فإن واشنطن تعتبر العلاقة بين مصر وإسرائيل إنجازا مهما لا يمكن التضحية به.
وتلعب مصر أيضا دورا حاسما في ضمان أمن إسرائيل، لا سيما على حدودها الغربية مع غزة، التي تسيطر عليها “حماس” منذ عام 2007.
وفي مناسبات عديدة، لعبت مصر دور الوسيط بين إسرائيل و”حماس”، ما ساعد في الحفاظ على وقف إطلاق النار ومنع اندلاع التوترات العسكرية بين الطرفين، وفي غضون ذلك، طورت القاهرة وتل أبيب أيضا علاقات أمنية واقتصادية قوية خلال العقود الأخيرة، خاصة في مجال النفط والغاز الطبيعي، ما يعزز مكانة مصر كشريك إقليمي مهم للولايات المتحدة.
وبالرغم من هذه العلاقة الفريدة، شهدت العلاقة الأمريكية المصرية توترات في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية والحريات المدنية وحقوق الإنسان.
وتحت إدارة الرئيس “جورج دبليو بوش”، ضغطت الولايات المتحدة على “مبارك” لاحترام حقوق الإنسان وإجراء إصلاحات سياسية.
كما حثت إدارة الرئيس “باراك أوباما” الحكومة المصرية على إطلاق سراح الناشطين السياسيين وتعليق القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني.
وردا على الاحتجاجات التي اندلعت في يناير/كانون الثاني 2011، دعت الولايات المتحدة “مبارك” إلى الاستجابة لمطالب المحتجين والسماح بنقل السلطة، وعندما رفض الرئيس المصري ذلك تخلى عنه “أوباما”، مما ساهم في سقوط “مبارك”.
وبالرغم من أن إدارة “أوباما” فشلت في إدانة انقلاب يوليو/تموز 2013 الذي أوصل “السيسي” إلى السلطة، لكنها علقت جزئيا تزويد الجيش المصري بالمعدات العسكرية في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام.
وجاء هذا القرار ردا على قمع النظام الوحشي للاحتجاجات السلمية، وكان هدف “أوباما” دفع مصر نحو إقامة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا عبر انتخابات مفتوحة ونزيهة، لا سيما بعد “مجزرة رابعة العدوية”.
وفي مارس/آذار 2015، تم رفع هذه القيود على شراء مصر للمعدات العسكرية بحجة احتياجات مكافحة الإرهاب في البلاد.
وفي عهد “ترامب”، وصلت العلاقات بين القاهرة وواشنطن إلى درجة غير مسبوقة من الانسجام والتعاون، وكان “عبدالفتاح السيسي” أول رئيس يهنئ “ترامب” بفوزه في انتخابات 2016.
وعُرف عن الزعيمين تمتعهما بعلاقة شخصية قوية، تعززت أكثر من خلال الدور الحاسم لـ”السيسي” في تسهيل ما يسمى بـ”خطة ترامب للسلام” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بالرغم أن أهداف الخطة تضمنت تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية على حساب الحقوق الفلسطينية.
وشجعت هذه العوامل على تجاهل إدارة “ترامب” لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي يرتكبها نظام “السيسي” ضد المعارضة السياسية في مصر.
وكذلك لم يواجه “السيسي” أي انتقادات بسبب سياساته الديكتاتورية تجاه الناشطين السياسيين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، وخلال فترة “ترامب”، قدمت الولايات المتحدة الدعم المباشر سياسيا وعسكريا واقتصاديا لنظام “السيسي”.
القاهرة بين القلق والخوف
وسوف يلاحظ من يتابع الصحافة المصرية مدى قلق النظام المصري وارتباكه بعد إعلان هزيمة “ترامب” في الانتخابات.
ويُشار إلى أن “السيسي” كان أول رئيس عربي يهنئ “جو بايدن” بفوزه، ووقعت القاهرة أيضا عقدا بقيمة 65 ألف دولار شهريا مع شركة ضغط مقرها الولايات المتحدة من أجل تعزيز التواصل وتطوير العلاقات مع الفريق الانتقالي لإدارة “بايدن”.
وكان دافع نظام “السيسي” لهذه الخطوات هو الخوف العميق من العودة إلى سياسات عهد “أوباما” التي اهتمت بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية والمجتمع المدني.
وتتفاقم هذه المخاوف بسبب توقعات باستجابة “بايدن” لضغوط بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي المهتمين بحقوق الإنسان، مثل السيناتور “كريس مورفي” والنائب “توم مالينوفسكي”، لوضع شروط لإيصال المساعدات العسكرية إلى مصر من بينها تحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
ويخشى نظام “السيسي” أن تفتح إدارة “بايدن” حوارا مع المعارضة المصرية في الخارج، ولاسيما جماعة “الإخوان المسلمون”، وأن تضغط من أجل اندماجهم في الحياة السياسية، وبالرغم أن مثل هذا الاحتمال غير مرجح، لكنه يظل أحد مخاوف “السيسي” بشأن الإدارة الأمريكية الجديدة.
وفي الوقت نفسه، قد يكون لانتصار “بايدن” تأثير معاكس ويساهم في تصلب موقف النظام ضد المعارضة، إذا رغب “السيسي” في إثبات أنه لا يخضع للضغوط الأمريكية.
ولعل هذا ما حدث في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما اعتقلت قوات الأمن المصرية العديد من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل “جاسر عبدالرازق”، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تفاؤل في غير محله
وتعيش مصر في ظل واحدة من أسوأ الديكتاتوريات في العالم العربي في الوقت الحاضر، وعلى مدى الأعوام الـ6 الماضية، خنق “السيسي” المعارضة، سواء كانت إسلامية أو علمانية، وبدلا من توسيع الحريات، بنى المزيد من السجون لحبس المعارضين والناشطين السياسيين والصحفيين، وفرض قيودا أكثر صرامة على المجتمع المدني.
وانتقلت مصر الآن إلى نظام حكم الرجل الواحد؛ حيث تتركز السلطة بالكامل في يد “السيسي” المدعوم من المؤسسة العسكرية التي تسيطر على المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وقد تفاقم هذا الوضع بعد أن تولى “ترامب” رئاسة الولايات المتحدة في عام 2016.
ومن المفارقات أن هناك تشابها صارخا بين استبداد “السيسي” وميول “ترامب” الاستبدادية، التي ظهرت خلال فترة رئاسته، وبالتالي، جاء رحيل “ترامب” من البيت الأبيض بمثابة نسمة هواء جديدة للمعارضة المصرية، ما زاد الآمال في أن يفتح “بايدن” طريقا لهم لكسب بعض النفوذ ووضع حد لانتهاكات “السيسي” المروعة لحقوق الإنسان.
ومع ذلك، يبدو أن أعضاء المعارضة المصرية، خاصة أولئك الذين يعيشون في المنفى، قد يكونون متفائلين بشكل مبالغ فيه في توقعاتهم من رئاسة “بايدن” وقدرتها على تغيير الوضع في مصر.
ومن المشكوك فيه استعداد واشنطن لممارسة ضغط حقيقي على “السيسي” لإحداث تغيير في سياساته الاستبدادية، وذلك لعدة أسباب:
أولا: من غير المرجح أن يخاطر “بايدن” بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط واشنطن بالقاهرة تاريخيا من أجل قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تشكل المصالح الاستراتيجية الأمريكية أولوية لأي إدارة أمريكية، سواء أكانت ديمقراطية أم جمهورية، حتى لو كان ذلك ينطوي على التعاون مع الأنظمة الاستبدادية.
ثانيا: لم يكن “بايدن” متحمسا للإطاحة بالديكتاتور المصري السابق “حسني مبارك” إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وفي الواقع، حافظ “بايدن” على علاقات جيدة مع “مبارك” بسبب المخاوف من التحولات المزعزعة للاستقرار والتي حفزتها الثورة في مصر.
ثالثا: من المهم أن نتذكر أن انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، فضلا عن القمع غير المسبوق والأحداث الدموية التي أعقبته بما فيها مذبحة رابعة، حدثت أثناء تولي “بايدن” منصب نائب الرئيس مع “باراك أوباما”، باختصار، من الصعب أن نتخيل أن “بايدن” سيتخذ إجراءات قاسية إذا حدثت هذه الانتهاكات مرة أخرى.
وأخيرا: لدى نظام “السيسي” مجال للمناورة في حال انتقدت إدارة “بايدن” سجله في الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقد يتجه شرقا إلى روسيا والصين من أجل ممارسة الضغط على الولايات المتحدة، وفي الواقع، اتبع “السيسي” هذا المسار خلال العامين الأخيرين لإدارة “أوباما” وعزز علاقته مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، وأبرم العديد من الصفقات العسكرية والتجارية والاقتصادية مع روسيا.
وبالمثل، خلال إدارة “ترامب”، أجرى الجيش المصري عدة أنشطة عسكرية مشتركة مع نظيره الروسي، كما عزز “السيسي” علاقات بلاده مع الصين، خاصة في القضايا التجارية والمالية والاقتصادية، ورفع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة.
لذلك، سوف تسير إدارة “بايدن” على خط رفيع بين الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية مع مصر ولفت الانتباه إلى سجل البلاد المروع فيما يخص الديمقراطية وحقوق الإنسان.
هل يوجد أمل؟
من المرجح أن تتجنب إدارة “بايدن” إجراء تغييرات جذرية أو دراماتيكية في علاقة الولايات المتحدة مع مصر، وقد حافظت الولايات المتحدة على هذه العلاقة بالفعل بالرغم من التوترات العرضية.
ومن المتوقع أن يستمر تعاون البلدين في مجالات الأمن والدفاع والاستخبارات والشؤون العسكرية دون الخضوع لتحولات كبيرة، خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة الأمن القومي يتحملان مسؤولية أكبر عن هذه العلاقات وإدارتها أكثر من البيت الأبيض.
ومن المرجح أن تظل التغييرات في النهج الأمريكي بلاغية وألا تشكل تغييرا حقيقيا في السياسة، ومن المتوقع أن توجه إدارة “بايدن” بعض الانتقادات إلى حملة النظام المصري على الشخصيات المعارضة والناشطين السياسيين، حيث انتقد “بايدن” علانية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام “السيسي” خلال حملته الانتخابية، بل أشار إلى أنه لن يقدم “شيكا على بياض” لـ”ديكتاتور ترامب المفضل”، ولعل هذا هو أكثر ما يقلق النظام المصري.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح ألا تقف إدارة “بايدن” في طريق التشريع الذي قد يمرره الكونجرس فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر، ومن المشكوك فيه أيضا أن يرحب “بايدن” بـ”السيسي” في البيت الأبيض، على الأقل خلال أول عامين من توليه المنصب.
وأخيرا، إذا حدثت انتفاضة شعبية في مصر في الأعوام المقبلة، فمن المحتمل أن تتخلى إدارة “بايدن” عن “السيسي”، كما فعل “أوباما” مع “مبارك” قبل عقد من الزمن.
وبالرغم من الآمال المتعلقة بفوز “بايدن”، خاصة بعد سياسات “ترامب” المروعة منذ عام 2017، فإن التغييرات الحقيقية في السياسة الخارجية الأمريكية، خاصة تجاه الدول الاستبدادية مثل مصر، ستضع هذا التفاؤل على محك اختبار حقيقي في الأعوام الأربعة المقبلة.