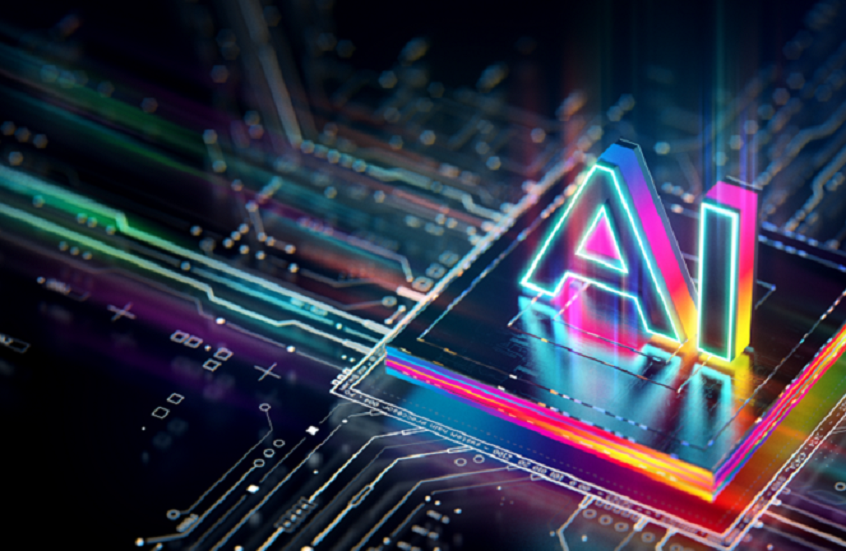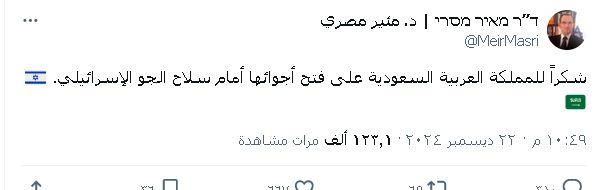العتبة الحسينية المقدسة :
ان القدرة البيانية في نصوص القرآن الكريم ، تجاوزت حدود المعرفة الانسانية العجلى ، حتى عادت ضرباً من الاعجاز ، وسنخاً جديداً من البيان العربي الذي لا يدانيه نصٌ أدبي .
والقرآن اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله تعالى كما يراه الشافعي ويرجحه السيوطي وعليه أئمة الأصوليين (1) .
وقد يكون مشتقاً من القراءة ومرادفاً لها باعتباره مصدراً (2) . وقد يكون مشتقاً من القرائن لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضاً ، ويشبه بعضها بعضاً كما يراه الفراء (3) .
وقد يكون معناه القراءة في الأصل ، أو مصدر قرأت بمعنى تلوت ، وهو المروي عن ابن عباس (4) ومنه قوله تعالى 🙁 إِنَّ عَلَينَا جَمعَهُ وَقُرءَانَهُ *فَإِذَا قَرأنَهُ فَاتَّبِع قُرءَانَهُ * ) (5) ثم نقل من هذا المعنى وأصبح إسماً لكلام الله تعالى ، ولا نميل إلى ما رجحه بعض المحدثين من أن العرب عرفوا القراءة لا بمعنى التلاوة ، بل أخذوها عن أصل آرامي لذلك ، وكان ذلك كافياً لتعريبه ، وإستعمال الاسلام له في تسميته كتابه الكريم (6) : بل الله سماه بذلك : ( إِنَّهُ لَقُرءَانٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكنُونٍ * (7) وعلى ذلك لغة العرب دون أصل أجنبي (8) .
وقد سبق في لوح الغيب أن اللغة العربية أشرف اللغات وأنصعها ، فأختارها الله تعالى لأشرف كتبه ، حتى أثبتت الدراسات المعاصرة إمتياز العربية وأولويتها في سلامتها وفصاحتها وأصالتها ، وهي تنطلق من صحارى الجزيرة ، ومفاوز الحجاز ، مخترقة مناخها الاقليمي ، وبقعتها الجغرافية إلى بقاع العالم ، ضاربة بأطنابها صوب المغرب والمشرق ، مما عجزت عن تحقيقه اللغات الحية ، وقصرت عن تناوله فصائل اللغات السامية ، حتى هجر جملة من علماء الاسلام ألسنة لغاتهم الأصلية ، تمحّضوا للغة القرآن فاحصين وباحثين ، فذاع صيتهم في الآفاق ، واشتهروا باسم العربية .
وكان القرآن الكريم أصل إفتتانهم بلغة العرب ، وأسلوبه مصدر حياتهم اللغوية المتنوعة ، فتعددت المعارف ، وتفتحت المدارك ، فكانت الإسهامات الحضارية ، والنقلة الثقافية تغزو المجتمعات والامم والشعوب والقبائل ، وتحرر العقول والذهنيات والألباب ، قال ابن قتيبة ( ت : 276 هـ ) : « إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره ، واتسع علمه ، وفهم مذاهب العرب وإفتنانها في الأساليب ، وما خصّ الله به لغتها دون جميع اللغات » (9) .
وكانت لغة قريش هي الأصل الذي نزل به القرآن على أفصح قريش فيما نسب إليه « أنا أفصح العرب بيد أني من قريش » (10) فكانت هذه اللغة مصونة بالقرآن ، ومحفوظة به ، نتيجة تضافر جهود علماء العروبة والاسلام في نفي الشوائب ، ودرئ الأخطار حتى سلمت هذه اللغة من التدهور والانحطاط اللذين عرضا لجملة من لغات العالم ، وعلى العكس من ذلك فقد إرتفعت لغة القرآن عن مستوى الانصهار في غيرها من اللغات ، وإعتصمت بمخزونها عن الدخيل من الألفاظ ، وهي بين هذه وذاك تصارع حركات العامية ، وتدحض شُبه الانقضاض على التراث ، وتسمو عن مسيرة الإذابة بالرطانات الأعجمية واللهجات الاقليمية ، حتى كتب لها الخلود ببركة القرآن العظيم ، وظلت رمز الشموخ الوضاء .
لا أريد التوسع في هذا الملحظ ، ولا التأكيد على هذا الجانب ، فهما من البداهة بمكان ، بل أحاول الاشارة من خلال ثلاث ظواهر جديرة بلفت النظر العلمي ، كانت أساساً صلباً لحفاظ القرآن المجيد على أصالة العربية :
الظاهرة الأولى :
وتتجلى في تسيير القرآن الكريم لعلومه المثلى ، وفنون معارفه العليا ، مما أعطى ظاهرة ذات ذائقة جديدة ، ولجت أبواب الوعي العربي في التصنيف والتأليف والبحث الجدي والمتابعة الفذة من قبل فحول العلماء وعلية القوم ، وكان تفسير القرآن يمثل الشطر الاكبر من هذه الظاهرة ، فبدأت مصادره تتألق ، وموارده تتواكب ، فكانت مدرسة مكة المكرمة ، ومدرسة المدينة المنورة ، ومدرسة الكوفة في تفسير القرآن الكريم ، معلماً بارزاً من معالم رفد العربية بكل ما هو أصيل ومبتكر ، فكانت مدرسة مكة ، وهي أندر عطاء ، وأغلى قيمة ، تستمد قوامها من النبي وآله وأصحابه ، وكان قوامها النخبة الرائدة من أصحاب ابن عباس ( ت : 68 هـ ) وابن عباس نفسه ، ومولاه عكرمة ( ت : 104 هـ ) ومجاهد بن جبر ( ت : 103 هـ ) وأمثالهما من الرواد الأوائل وكانت مدرسة المدينة المنورة ، قد إمتازت بالتجرد والموضوعية ، والكشف عن مراد الله من كتابه ، فيما أثر عنها من روايات محددة ، وكان قوامها ثلاثة من أئمة أهل البيت هم : الامام علي بن الحسين زين العابدين ( ت : 95 هـ ) والامام محمد الباقر ( ت : 114 هـ ) والامام جعفر الصادق ( ت : 148هـ ) كما اعتمدت طائفة من تلامذة أبي بن كعب ( ت : 105 هـ ) وأصحاب زيد بن أسلم ( ت : 136 هـ ) .
وكانت مدرسة الكوفة غنية بعطائها الثّر في إتجاه تدريسي يمثله ابن مسعود ( ت : 32 هـ ) وجملة من تلامذته ، وفي طليعتهم مسروق بن الأجدع ( ت : 63 هـ ) والأسود بن يزيد ( ت : 75 هـ ) والربيع بن خثيم ، وعامر الشعبي (ت : 105 هـ ) وأمثالهم .
وقد برز في الكوفة إتجاه نصّي يمثله تلامذة الامامين محمد الباقر وجعفر الصادق عليهما السلام نشأت عنه طبقتان تقيدت بنقل النصوص رواية وكتابة ، وكان في طليعة الرواة : زرارة بن أعين الكوفي ، وفي طليعة المؤلفين فرات بن إبراهيم الكوفي .
ولا ينسى دور مدرسة البصرة فيما أثر عن أبي عمرو بن العلاء ( ت : 145 هـ ) وعيسى بن عمر الثقفي ( ت : 149 هـ ) وقبلهما الحسن البصري ( ت : 114 هـ ) فيما أُصّلَ عنده من جهود تفسيرية منتشرة في أمهات التفاسير .
كانت هذه المدارس بما أبقت لنا من تراث تفسيري ضخم يعتمد الرواية حيناً ، والاستنباط العقلي حيناً آخر سبيلاً إلى نشوء حركة التفسير التسلسلي المنظم عند العرب والمسلمين فبدأ ذلك متكاملاً في محتوياته عند أبي جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت : 310 هـ ) في تفسيره الشهير ( جامع البيان ) واستمر العطاء الجزل إلى اليوم حافلاً بتفسير القرآن بالقرآن ، والتفسير البياني ، والتفسير التشريعي ، والتفسير المعجمي ، والتفسير الموضوعي ، وكان البعد الاحتجاجي متوافراً في التفسير الكلامي والوعي الفلسفي ، والأثر العرفاني ، والمنهج الاشاري ، وكان المناخ العقلي يتقلب بين شؤون الجدل المنطقي ، وسمات الروح الصوفي ، فصقلت الحياة العقلية بمزيج من الآراء الكلامية يتخير من ثمارها العربي ما أراد .
وكان هذا الزخم الحضاري حرياً بطرح كل الفروض الفكرية في رحاب العربية ولغتها الفياضة ، فأنت معه في معين مترافد لا ينضب ، وشعاع متألق لا يخبو ، هذا كله إلى جنب علوم القرآن وما أورثته للعربية من التفتح على آفاق جديدة في ظاهرة الوحي ، وأسباب النزول ، وجمع القرآن ، وخضم القراءات ، وحياة النسخ ، ومجال الامثال ، وطرق التشريع ، وإرساء المصطلح في المحكم والمتشابه ، والمجمل والمبين ، والخاص والعام ، والمطلق والمقيد ، وما أضاف ذلك من تنظير فجائي في لغة الجدل ، وعالم الحجاج ، مما كانت معه العربية حافلة بقيّم خلاقة جديدة ، نوّرها القرآن في علومه حتى قال ابن مسعود :« من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن » (11) . وتثوير القرآن يعني التدبر فيه ، والبحث عن جزئياته ، والعكوف على حيثياته الكبرى ، وفي هذا دعوة واضحة إلى الاجتهاد ، وإعمال الفكر مما تتسع له دائرة علوم القرآن في ميادينها عند رد الأصول إلى الفروع ، والنظم إلى متعلقات التركيب ، واللغة إلى جذورها في التصريف والاشتقاق .
وهكذا ظهر لنا التأريخ الحضاري المشترك بين اللغة العربية والقرآن الكريم مما شكل مظهراً إجتماعياً متلازماً ، فالحفاظ على اللغة يعني الحفاظ على القرآن ، وصيانة لغة القرآن يقتضي صيانة لغة العرب ، لارتباط وجودها التأريخي بوجوده التشريعي ، وأستمرار رقيها بلمح من إستمراره ، ولما كان القرآن الكريم ، معجزة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الخالدة ، وهو مرقوم بهذه اللغة الشريفة ، فالخلود متصل بينهما رغم عادية الزمن ، وهذا أمر يدعو إلى الاطمئنان على سلامة اللغة ، وأصالة منبتها . وهنا يتجلى أثر تيسير القرآن في تفسيره وعلومه بالكشف عن أسرار العربية وكنوزها دون عناء ومشقة (12) .
الظاهرة الثانية :
وتبرز ملامحها في تيسير القرآن العظيم ، لمعالم اللغة ، ومعاني النحو ، ودلالة الألفاظ ، مما أوجد حركة لغوية دائبة ، وأصالة إعرابية متجددة ، نشأت عنهما مناهج اللغة من جهة ، ومدارس النحو من جهة أخرى .
فالمنهج اللغوي عند العرب مدين بإرساء قواعده لأصالة القرآن ، فهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت : 180 هـ ) وسيبويه ( ت : 180 هـ ) والفراء ( ت : 207 هـ ) وأبو عبيدة ( ت : 210 هـ ) وابن قتيبة ( ت : 276 هـ ) إنما كتبوا العين ، الكتاب ، معاني القرآن ، مجاز القرآن ، غريب القرآن ، فلأن رائدهم الحثيث إلى هذا التوجه هو العناية بلغة القرآن ، فكان مددهم بمعين المفردات والصيغ والتراكيب في اللغة والحجة والنحو والصرف والقراءات ، ألم يكن مضمارهم في الإبانة عن إستعمالات العرب ، وطرق بيانهم ، فابتنى الأصل اللغوي عندهم بكثير من أبعاده على الغريب والشكل والأوابد والشوارد في الألفاظ والكلمات والمشتقات مما كان أصلاً للبناء اللغوي والنحوي والصرفي ، فكان القرآن عندهم مظنة إستنباط القواعد لاستلهام الحجة إثر الحجة في ميدان المعرفة اللغوية ، وجلاء معاني مفردات العربية ، وكانت إستعمالات القرآن أساس الدربة في البحث عند تتبع غريب العربية ، وإستقصاء معجم ألفاظها اللغوية .
قال الراغب ( ت : 502 هـ ) : « فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته ، وواسطته وكرائمه ، وعليها إعتماد الفقهاء في أحكامهم وحكمهم ، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم » (13) .
وكان إستئناس أعلام العرب بمفردات القرآن دليلاً حافزاً لأعلام الأوروبيين في فهرسة ألفاظ القرآن بإطارها العلمي ، المنظّم ، فحينما تأصلت الفكرة عند المستشرق الألماني الأستاذ جوستاف فلوجل ( 1802 م ـ 1870 م ) ألف أول معجم مفهرس للقرآن في اللغة العربية عني بألفاظ القرآن ومفرداته ، وأسماه : « نجوم الفرقان في أطراف القرآن » وطبع لأول مرة عام 1842 م في لا يبزج ، وكان هذا العمل الجليل أساساً محكماً لما إعتمده الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في وضع : ( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) (14) .
وقد إستأنس مجمع اللغة العربية في القاهرة بهذا المنهج الرائد ، فأصدر معجم ألفاظ القرآن الكريم في مجلدين ضخمين ، قام بإعداده جماعة من الأساتيذ والعلماء والمتخصصين ، فعرضوا لمفردات القرآن كافة ، فكان العمل أوسع ، والدائرة أشمل ، والأحصاء أكثر ، فكل كلمة ترد في القرآن تشرح شرحاً لغوياً ، ويحصر تردد ورودها في القرآن ، وينص على المعاني المختلفة للكلمة الواحدة ، ويشار إلى مجازية بعض المفردات ، كما يشار إلى مواطن الاستعمال الحقيقي .
أما مدارس النحو العربي فكان سعيها وراء ضبط قراءة القرآن وأدائه سليماً على النحو العربي الفصيح ، دون الوقوع في طائلة اللحن ، وتساهل العامة في القراءة ، ليسلم النص القرآني من التحريف والايهام معرباً بإبانة ، ومشرقاً بوضوح ، فبداية الضبط في نقط المصحف من قبل أبي الأسود الدؤلي ، أو يحيى بن يعمر العدواني ، أو نصر بن عاصم (15) إنما كان صيانة للقرآن من اللحن على حد تعبير النووي : « ونقط المصحف وشكله مستحبٌ لأنه صيانة من اللحن والتحريف » (16) . وبدأ التحوط على القرآن فيما وضعه أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام من معالم النحو على روايات منها :
أ ـ حينما سمع إعرابياً يقرأ ( لاَّ يَأكُلُهُ إِلاَّ الخَطِئوُنَ * ) (17) ، فوضع النحو .
ب ـ حينما دخل عليه أبو الأسود على الامام علي عليه السلام فوجد في يده رقعة ، يقول أبو الأسود ، فقلت : ما هذه يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء يعني الاعاجم ، فأردت أن أضع شيئاً يرجعون إليه ، ويعتمدون عليه ، وإذا الرقعة فيها : الكلام كله : اسم وفعل وحرف ، فالاسم ما أنبأ عن المسمى ، والفعل ما أنبئ به ، والحرف ما أفاد معنى . وقال لي : أنحُ هذا النحو ، وأضف إليه ما وقع إليك » (18) .
ومهما يكن من أمر فإن الاستاذ أحمد أمين يميل إلى أن شكل المصحف في نقطه وإعجامه خطوة أولية في سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء ، يمكن أن تأتي من أبي الأسود (19) .
والحقيقة أن اللحن في قراءة القرآن ـ بعد أن اتسعت رقعة الاسلام ـ كان سبباً مباشراً في تأسيس النحو العربي ، حتى روي لنا لحن الحجاج والحسن البصري (20) .
وكانت البداية التأسيسية ـ بالاضافة إلى ما سبق ـ على يد البصريين حينما ألف عبد الله بن أبي إسحاق ( ت : 117 هـ ) كتاباً في الهمز (21) .
وتبعه عيسى بن عمر الثقفي ( ت : 149 هـ ) فألف كتابين هما : الأكمال والجامع (22) .
حتى إذا نبغ الخليل ( ت : 175 هـ ) وأخذ بزمام الدرس النحوي ، قامت مدرسة البصرة في النحو على يديه ، ونشأ مترعرعاً في ظلال توجيهه تلميذه سيبويه ( ت : 180 هـ ) فأتسمت ملامح المدرسة بمناهجه ، وتأصلت مسائلها بفضله ، فكان « الكتاب » أول أصل مدرسي جمع مادة النحو العربي ، وكان منهجه متأثراً بالقرآن الكريم جزئياً في توجيه الاعراب حيناً ، وتيسير القواعد حيناً آخر ، لأن القياس هو الأولى عند البصريين ، وإن كان الهدف تقويم اللسان العربي عن اللحن والخطأ ، للحفاظ على سلامة القرآن الأدائية .
حتى إذا نشأت مدرسة الكوفة على يد أبي جعفر الرؤاسي ( ت : 148 هـ ) وتلميذه النابه علي بن حمزة الكسائي ( ت : 189 هـ ) وأشهر تلاميذ الكسائي : يحيى بن زياد الفراء ( ت : 207 هـ ) ، كان الاستناد إلى القرآن أكثر شيوعاً والاستدلال بشواهد من آياته أرحب مجالاً ، لأن الكوفيين « يؤمنون أن القرآن جاء بلغات فصيحة ، فهو أحق بالقبول ، وأجدر بالأخذ ، حينما تبنى قاعدة ، أو يقرر حكم ، أو يصحح أسلوب » (23) .
فكان عمل الكوفة في ظواهر الكتاب حيناً ، وفي القياس النحوي حيناً آخر ، وليتهم إكتفوا بالشاهد القرآني وحده ، ولم يخضعو لسلطان القياس ، لكان القرآن هو المرجع ليس غير .
إن نشوء هاتين المدرستين في ظل العلم العراقي الفياض ، كان هو الأساس لسلامة اللغة العربية ، وعليه سار المتأخرون من النحاة ، فكان الثروة الطائلة في كل زمان ومكان ، لأن مصادر الدرس النحوي في تفتقت عنهما ، وهما وحدهما موارد هذا العلم لمن أراد الإستزادة ، وكان الدافع الحقيقي وراء هذه الجهود المترامية الأطراف هو الدفاع عن القرآن ، وصيانة التراث من الهجمات المضادة ، وإبقاء العربية علماً شامخاً في حياة اللغات .
الظاهرة الثالثة :
وتتجلى مظاهرها في حياة البلاغة العربية ، فقد نشأت البلاغة العربية في أحضان الاعجاز القرآني ، وتلألأ نجمها في قضايا البيان في القرآن ، فكان الجاحظ ( ت : 255 هـ ) من أوائل من أكدوا هذا الجانب في جملة من أسراره الجمالية ، فخصص كثيراً من مباحثه في « نظم القرآن » لاستيفاء كنوز العبارة القرآنية ، وإستخراج ما فيها من مجاز وتشبيه بمعانيهما الواسعة ، وكذلك صنع في « البيان والتبيين » فتجد المجاز إلى جنب الكناية القرآنية ، والاستعارة مستقاة من تشبيهات القرآن ، وعمله هذا وإن كان مفرقاً ومجزءاً إلا أنه كان مناراً لمعالم الطريق .
حتى إذا جاء ابن قتيبة ( ت : 276 هـ ) وجدناه يؤكد دلائل مادة علمي المعاني والبيان في صدر كتابه « تأويل مشكل القرآن » مستنداً إلى التنظيرات البلاغية من القرآن في ضوء طرق القول ومأخذه عند العرب في الاستعارة والتمثيل والقلب التقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء والإظهار والتعريض والافصاح والكناية والايضاح ، مما أورده مستنيراً بآيات القرآن ودلائله في أبواب المجاز (24) .
وكان علي بن عيسى الرماني ( ت : 386 هـ ) في « النكت في إعجاز القرآن » وحمد بن سليمان الخطابي ( ت : 388 هـ ) في « بيان القرآن » وأبو هلال العسكري ( ت : 395 هـ ) في « الصناعتين » وأبو بكر الباقلاني ( ت : 403 هـ ) في « إعجاز القرآن » والسيد الشريف الرضي ( ت : 406 هـ ) في « تلخيص البيان في مجازات القرآن » قد استمدوا من كتاب العربية الأكبر روافد الاعجاز البياني ، وروائع الفن البلاغي ، فتلمس آثار قضايا الاعجاز ، وتلمح بصمات كتاب الله في ثنيات جوهر البلاغة وأساسها ، والتدوين المشترك بين أصول البلاغة وشواهد الآيات يعطيك نماذج التطبيق .
فإذا استقريت جهود عبد القاهر الجرجاني ( ت : 471 هـ ) تجده بحقٍّ مؤسس الفن البلاغي ، ومشيد أركانه في ضوء القرآن العظيم ، فالفاحص لكتاب « دلائل الاعجاز » يلحظ مباحثه منصبَّة بسيولها المتشعبة حول علم المعاني بكل تفريعاته الجمالية والاسلوبية ، والمستقري لكتاب : « أسرار البلاغة » يجده متخصصاً بعلم البيان وصوره كافة ، باستثناء الكناية التي قدم عنها بحثاً مفصلاً في الدلائل .
إن الجزئيات التي أثارها عبد القاهر ، والأبواب التي أستوفى الحديث عنها ؛ تعدّ بحق الحجر التأسيسي لمفاهيم علم البلاغة مستمدة من القرآن ؛ في المستوى التطبيقي والنظري ، وهو بذلك الفكر المخطط الرائد لجملة هذه الأفكار ، والمنظّر المتمكن من هذا الفن .
من خلال هذا الاختصار فيما قدمت ، تجد التفاعل الحضاري قائماً بين كتاب الله وعلم البلاغة العربية الذي هو جزء متسلسل عن القرآن ، ويتعرف الباحث بتأكيد بالغ أن هذا العلم إنما قام ونهض وترعرع ـ فضلاً عن نشوئه ـ من أجل إثبات بلاغة القرآن ، فكل بلاغة دونها ، وكل بليغ لا يصل إليه ولا يواكب تلاطم أمواجه ، مما يدفع ما وسم به هذا التراث العربي الاسلامي المحض من سمات لا أساس لها ، فلا الأصل اليوناني ينطلق من واقع علمي ، ولا الأثر الاعجمي بحقيقة تأريخية ، بل البلاغة في أصولها وفروعها وتضاعيفها مستندة إلى القرآن في ينابيعه الأولى ، فالعربي على فطرته البدوية الصافية تهزه الكلمة العذبة ، وتطربه العبارة الفصيحة ، وتمتلك نفسه الاستعارة الهادفة ، وتسترعيه الكناية المهذبة ، ويستهويه التشبيه المعبر ، ويقف عند المجاز السيّار ، وكان ذلك من بركات القرآن وجليل آثاره البيانية ، وسبق فنه القولي فنون العرب في الأداء والاسلوب والنظم ورصانة التأليف .
لقد بهر العرب بجمال القرآن وروعه ، ونظروا إلى التغيير الجذري الذي أحدثه هذا الوحي الهادر ليس في العادات المفاهيم والتقاليد فحسب ، بل في القول وفنون الكلام والنظم البياني ، فقد نظروا إلى لغتهم وهي تتجه ـ فجأة ـ نحو الاستقامة والاستقرار والصعود ، فحدبوا على عطاء هذه اللغة يختزنونه ، وعمدوا إلى مرونتها يستغلونها إستغلال يسر وسماح ، فكان هذا المخزون جمالاً بلاغيَّا لا يبلى ، وكان ذلك الاستغلال موروثاً بيانياً لا ينفد ، وما ذاك إلا نتيجة إستجلائهم دلالات القرآن الادبية ، وتغلغلهم بأعماق فنونه البلاغية ، فالقرآن إلى جانب عطائه اللغوي والاسلوبي قد خلص اللغة من فجاجة الوحشي والغريب ، وهذّب طبع ألفاظها من التنافر والتعقيد ، فلم يعد العربي بعد بحاجة إلى إقصاء ذلك وإستبعاده ، فكأنه لم يكن ، فقد تكفل القرآن بتذليل الصعاب .
العرب اليوم مدعوون إلى تأكيد هذا التلاحم الفاعل بين كتاب الله تعالى وبين الفن البلاغي ، وذلك بالكشف عن خبايا هذا الكتاب وكنوزه ، وإستكناه وجوه الاعجاز البياني في ظلال آياته ، إذ لا شوائب في لغة القرآن وألفاظه ، ولا معاناة في تحسس جماله العام ، والجهد الكبير المتواصل كفيل بالوصول إلى الأمثلة النادرة ، ففيها وحدها يتقوم الأصل البلاغي الموروث ، بعد أن كان الطبع السليم عند العرب يكشف عن هذا الملحظ بذائقته الخالصة .
الكاتب: الدكتور محمد حسين علي الصغير
ألقي في المؤتمر العلمي الخامس المنعقد في كلية الفقه في النجف الأشرف / جامعة الكوفة للفترة 5 ـ 7 جمادى الأولى 1410 هـ = 3 ـ 5 / 12 / 1989 م .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ظ : السيوطي ، الأتقان في علوم القرآن : 1 / 51
(2) ظ : محمد عبد الله دراز ، النبأ العظيم : 7
(3) ظ : الألوسي ، روح المعاني : 1 / 11
(4) ظ : الطبرسي ، مجمع البيان : 1 / 14
(5) القيامة : 17 ـ 18
(6) صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن : 12
(7) الواقعة : 77 ـ 78
(8) ظ : ابن منظور ، لسان العرب : مادة : قرأ
(9) ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن : 11
(10) ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة : 60
(11) ابن الاثير ، النهاية في غريب الحديث : 1 / 229 .
(12) ظ : المؤلف ، المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم : 38 .
(13) الراغب ، المفردات : 6 .
(14) ظ : المؤلف ، المستشرقون والدراسات القرآنية : 62 .
(15) ظ : ابن عطية ، مقدمتان في علوم القرآن : 276 + الزركشي ، البرهان : 1 / 250 .
(16) السيوطي ، الاتقان في علوم القرآن .
(17) الحاقة : 37 .
(18) ابن الانباري ، نزهة الالبا : 4 ـ 7 .
(19) أحمد أمين ، ضحى الاسلام : 2 / 286 .
(20) ظ : الجاحظ ، البيان والتبيين : 2 / 219 .
(21) ظ : السيوطي ، المزهر : 2 / 398 .
(22) ظ : ابن النديم ، الفهرست : 68 .
(23) عبد العال سالم مكرم ، القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية : 123 .
(24) ظ : ابن قتيبة ، تأويل مشكل القرآن : 15 .
………