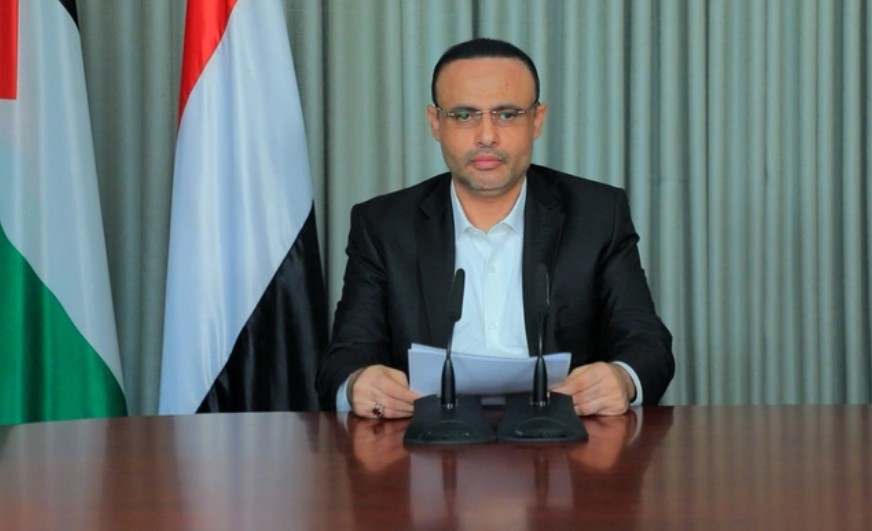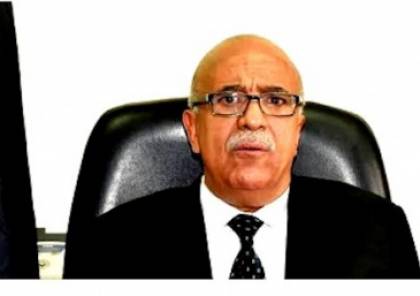ويقول التقرير إنَّ الطريق ذا الاتجاهين، الذي كان موجودًا في القرن التاسع عشر، عندما كان ثمة حوار بين علماء المسلمين في جنوب آسيا والشرق الأوسط، بما في ذلك علماء مكة والمدينة؛ قد صار الآن من الماضي.
ويذكر التقرير نقلًا عن الكتاب؛ إنَّه وعلى الرغم من تعرضها لهجمات، إلا أن الأضرحة لا تزال جزءًا من الإسلام الشعبي، إذ لا يزال المسلمون يزورونها، جنبًا إلى جنب مع الهندوس والمسيحيين والسيخ. ومع أنَّ هذا البُعد من المشهد الديني شائع في كل أنحاء جنوب آسيا، إلا أنه أكثر وضوحًا في الجانب الهندي، إذ لا يزال الحجاج يحضرون الموالد، ويتقدم الباكستانيون بطلب تأشيرات دخول، من أجل زيارة ضريح «أجمير دارغه شريف» وأضرحة أخرى.
ومن المثير للاهتمام؛ أنَّ الصوفية استطاعت أن تشق لنفسها طرقًا في ممالك الخليج، سائرة على خطى الشتات الجنوب آسيوي، وأنشأت أيضًا روابط مع الشبكات الصوفية الباحثة عن الدعم في الوطن، ضد التجاوزات السلفية المتشددة.
وتُعد الإقليمية، التي عادة ما يتم خلطها بالصوفية؛ ترياقًا ضد السلفية في مقاطعات مختلفة في جنوب آسيا، إذ جرى احتواء التأثيرات السلفية الخارجية بشكل أكثر فعالية، عندما التقت الثقافات المحلية مع التدين الشعبي الذي تمثله الصوفية بامتياز. وطائفة «السند» مثال على ذلك؛ إذ ينظر السنديون القوميون لأنفسهم على أنهم أحفاد الحضارة الهندوسية، واعتاد كبير منظريهم؛ جي إم سيد (1904- ـ1995)، على ترديد: «أنا سندي منذ 5 آلاف عام، ومسلم منذ 1400 عام، وباكستاني منذ 63 عامًا».
«المد السعودي» في باكستان
من الواضح أنه على الرغم من مرونة المفاهيم والممارسات المحلية للدين الإسلامي، فإنَّ ثمة عملية «سعودة» للإسلام تحدث في جنوب آسيا، إذ تعد الدولة، في باكستان، فاعلًا أساسيًا في هذه العملية، وهي مسألة يجدر التشديد عليها. فالنفوذ الديني المتزايد للسعودية في باكستان يعد من إرث سياسة الأسلمة التي انتهجها «ضياء الحق» (جنرال باكستاني، وصل إلى السلطة عبر انقلاب على الرئيس ذو الفقار علي بوتو)، ومنذ ذلك الوقت، والحكومة تتأرجح بين فترات طويلة من التقارب مع السعوديين، وفترات قصيرة من الوقوف على مسافة واحدة مع كلٍ من السعودية وإيران.

وقد كانت إسلام آباد أقرب إلى الرياض، عندما كانت تحت حكم رجال من الجيش، أو الرابطة الإسلامية الباكستانية (نواز)، وهو حزب لجأ زعيمه، نواز شريف، إلى جدة بين عامي 2000 إلى 2007، عندما نفاه الجنرال مشرف بعد انقلاب عام 1999. ولعائلة شريف بالفعل روابط طيبة مع الأسرة السعودية الحاكمة، لكنَّ أواصر هذه الروابط تقوَّت بعد ذلك، إذ لم يقتصر الأمر على زواج إحدى بنات نواز بحفيد الملك فهد، وإنما طور نواز وشقيقه عددًا كبيرًا من الشراكات في السعودية، التي كانا يزورانها في كثير من الأحيان، لأسباب لا تقتصر على الحج فقط.
وعلى النقيض من ذلك؛ عندما كان حزب الشعب الباكستاني في السلطة، حاولت الحكومة تعزيز العلاقات مع إيران، الأمر الذي أرجعته الرياض إلى الخلفية الشيعية لعائلة بوتو. ومع أنَّ ذو الفقار علي بوتو، منشئ الحزب، لم يعلن قط إذا كان شيعيًا أم لا، إلا أن زواجه من امرأة إيرانية أثار الشكوك. وعندما أصبح آصف زرداري، أرمل بينظير بوتو، رئيسًا عام 2008، فضّل إقامة علاقات متوازنة مع إيران.
اقرأ أيضًا: مترجم: انحراف اليهودية.. يهودي يدلل من التوراة أن القدس ليست مقدسة عند اليهود
وقد وقع تطور مشابه على الجانب الهندي؛ مع قيام عبد الكريم ذاكر نايك، بإنشاء قناة «بيس تي في»، التي يقال إنَّ عدد مشاهديها وصل إلى 100 مليون مشاهد، إذ ينتقد ذاكر نايك الولاءات الصوفية والتشيع بمصطلحات صريحة نوعًا ما.
وإلى جانب وسائل الإعلام الإلكترونية، فإنَّ الاتصالات المادية تكثفت هي الأخرى؛ إذ ارتفع عدد الحجاج الباكستانيين من 12300 عام 1948 إلى 58743 عام 1974، ثم تخطى حاجز الـ100 ألف حاج بحلول أواخر القرن العشرين، ليصل إلى 190 ألف حاج عام 2012. وقد انتقلت التأثيرات الإسلامية عبر المهاجرين أيضًا؛ فثمة الكثير من قصص المسلمين الهنود الذين أصبحوا أكثر تشددًا خلال إقامتهم في الخليج.
وقال التقرير إنه بعيدًا عن المسارات الفردية، فإن السعودية تدعم المؤسسات السلفية في جنوب آسيا، بما في ذلك ولاية كيرالا، حيث أُعيد توطين المهاجرين السابقين بعد عودتهم. وبحسب برقية من السفارة السعودية في دلهي، فإنَّ ملايين من الريالات قد خُصصت لصالح صندوق البعثة الإسلامية في مالابورام (كيرالا). ومؤخرًا، بدأت منظمتان إسلاميتان في الاستفادة من الدعم المالي السعودي في جنوب الهند، ولا سيما في كيرالا، وهما: الجبهة الشعبية للهند، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الهندي.
ويشير فيليبو وكارولينا أوسيلا إلى أنَّ «التوجه الإسلامي الشامل»، لمسلمي هذه الولاية قد ازداد خلال السنوات الثلاثين الأخيرة لسببين: «أن الهجرة إلى الخليج لم تقتصر على جلب آلاف المسلمين الماليباريين إلى ما يتخيلونه قلب الإسلام، وعرضتهم مع كل ما ينجم عن ذلك من تناقضات وتضارب، إلى الحياة في بلدان ذات أغلبية مسلمة، لكنها أيضًا جددت من الروابط مع علماء الدين العرب، مما أنتج ثمة شعورًا بالتشارك في نهضة عالمية من «القيم الأخلاقية والثقافة الإسلامية».
واليوم يزداد انتشار السلفية مع التعليم، الذي يعد عاملًا أساسيًا من عوامل التحول الاجتماعي في كيرالا؛ إلى الدرجة التي صار معها الإيمان بالأولياء والتصوف «مرتبطًا بالجهل، والخرافات، والخراقة؛ وينظر إليه بصفته سمتًا ريفيًا (مابيلا) أو أمرًا خاصًا بالمسلمين الفقراء».
التشيع العابر للقوميات والنفوذ الإيراني
أخيرًا؛ وفيما يتعلق بالإسلام الشيعي، فقد أكد الكتاب أنَّ الشبكات العابرة للقوميات، المنسوجة حول مراكز المرجعيات الدينية في العراق وإيران، لا تزال تمارس قدرًا كبيرًا من النفوذ في هيكلة مشهد التشيع في جنوب آسيا، إذ تُعد الدراسة في العراق أو إيران، أمرًا إلزاميًا على كل رجل دين شيعي طموح، ولا يتعلق الأمر فقط بالرمزية الشرعية، بل أيضًا من أجل الحصول على موارد مالية. وفي المقابل، لا يوجد شيء مماثل لذلك لدى السُنّة، إذ لم تستطع الجزيرة العربية تحقيق المركزية الدينية الجديدة، في ظل احتكارها الراسخ للسلطة الدينية.
ويمكن القول إن مركزية العراق وإيران بالنسبة للشيعة في جنوب آسيا، ما هي إلا انعكاس للديناميكية الهندوسية الفارسية القديمة، التي شكلت على وجه الخصوص سياسة الإمبراطورية المغولية وثقافتها، وأن قدرة المؤسسات الشيعية القديمة على الصمود كانت جوهر النشاط الشيعي، بعيدًا عن محاولات تهميشها بعد ظهور الإسلام السياسي.
ومن ناحية؛ فإنَّ صعود القومية الهندوسية في الهند يُحول المسلمين الهنود، تدريجيًا، إلى مواطنين من الدرجة الثانية، بينما على الجانب الآخر، يفقد النمط الجنوب آسيوي من الإسلام بعضًا من «استقلاليته» بسبب النفوذ المتنامي القادم من الخليج، إذ تتعرض الطقوس الصوفية بالفعل إلى الهجوم في باكستان، فيما يكتسب الخطاب الطائفي زخمًا، ويحتشد المناضلون السنة حول فكرة الخلافة مرة أخرى. وحتى لو أظهر التصوف بعض المرونة، فإنَّ الحضارة الهندية الإسلامية سوف تحول نفسها حتمًا إلى شيء جديد في القرن الحادي والعشرين.